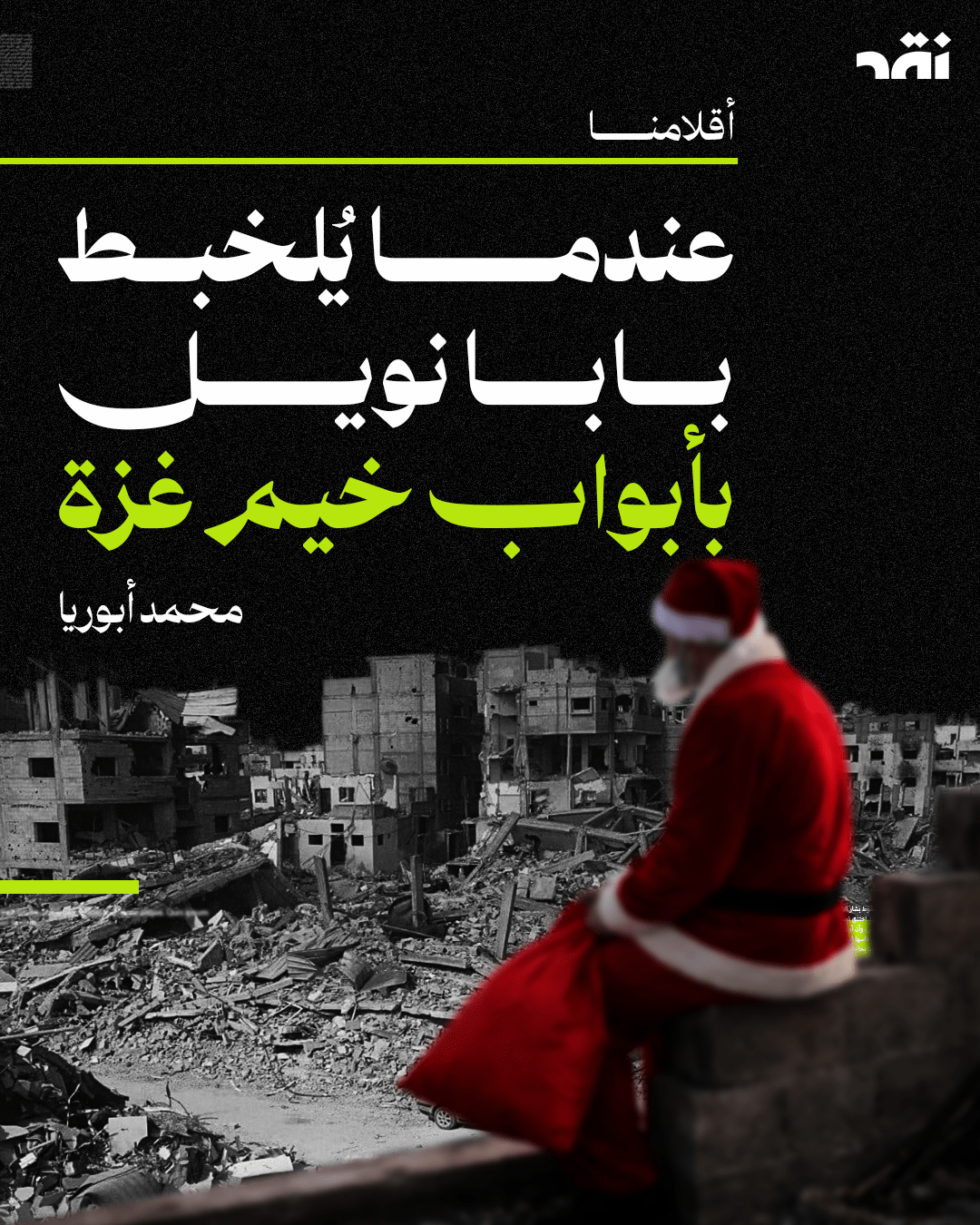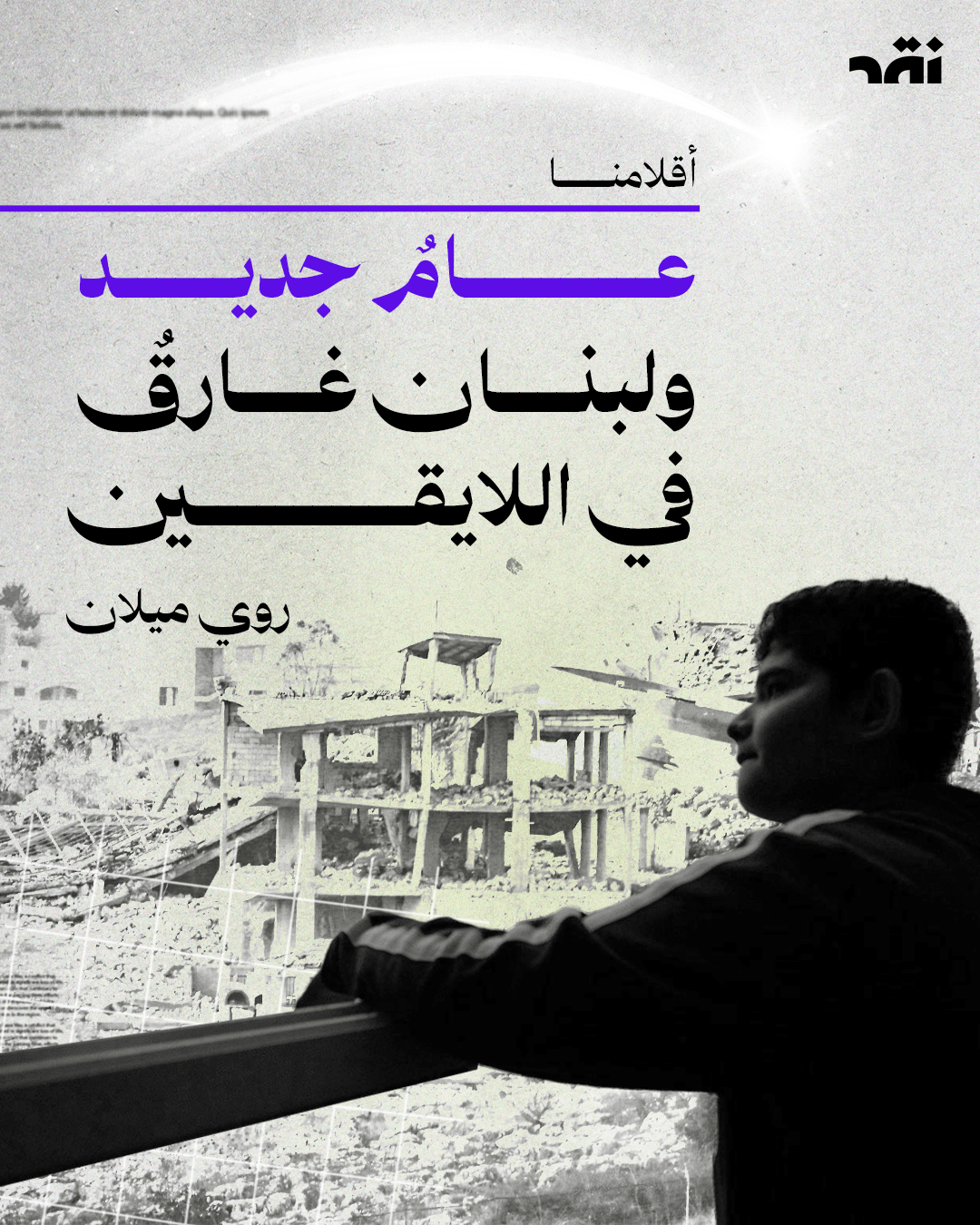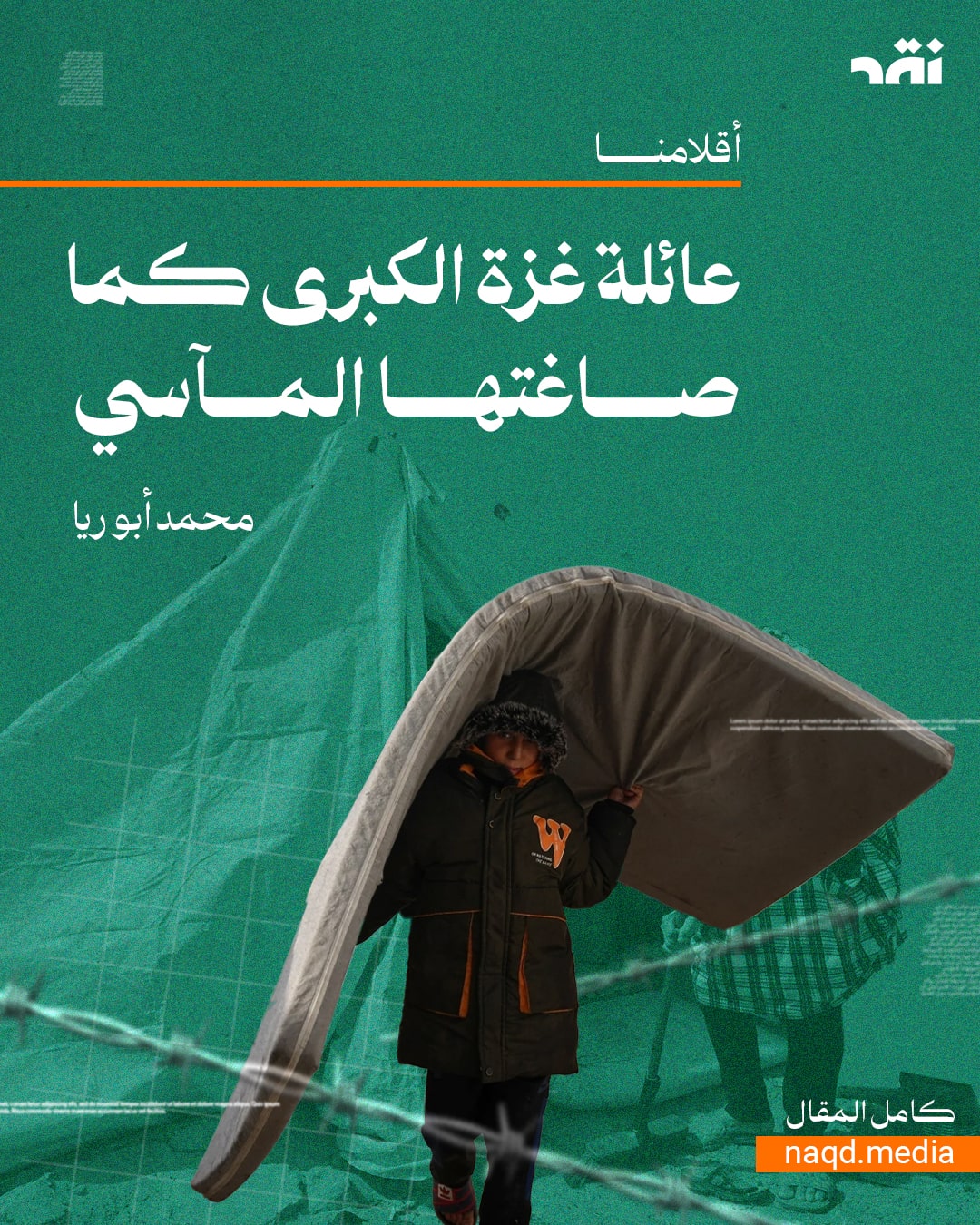يوميّات سوريا الغارقة في الرماديّة
19 Dec 2025
Like this post
في كل صباح من بداية هذا الشتاء، حين أستيقظ على برد يتسلّل من بين شقوق الذاكرة قبل أن يصل إلى أصابعي، أمدّ يدي تلقائيًا نحو سترتي ذات القبّة الخنق المعلّقة على ظهر الباب. هذه الياقة الطويلة صارت جزءاً من يومي، ليست لأنها تدفئ رقبتي فحسب بل لأنها تشبه الإحساس الذي لم يغادر الكثير من السوريين لحظة منذ بدأت البلاد تتغير، ذلك الشعور بأنّ شيئاً ما يلتفّ حولك.. يحميك من جهة.. ويضيّق عليك النفس من جهة أخرى. قميص بسيط لكنه يحمل رمزاً لحياة كاملة تعلّمت فيها الحذر والتربّص والاحتمال، وها أنا اليوم أحاول أن أفهم نفسي من خلاله، كما أفهم سوريا من خلال تفاصيلها اليومية الصغيرة.
حين أخرج من بيتي تبدو الشوارع مختلفة عن السنوات الماضية! هناك شيء يشبه الفرح لكنه غير قادر على أن يكتمل. وكأن البلاد تُجَرِّب وجهاً جديداً لم تتقنه بعد. بعد سقوط النظام البائد أو سقوط صورته الحديدية على الأقل نشأت فرحة أوليّة بين الناس، فرحة لا يُنكرها أحد لكنّها ليست صافية كالماء. هي فرحة تشبه تنفّساً أخيراً بعد غطس طويل، تتلوه مباشرةً دهشةٌ من الضوء وارتباكٌ حيال ما يجب فعله بعد النجاة.
على وجوه الناس ترى هذا الارتباك! ابتسامة خفيفة، يليها التفاتٌ حذر. حديثٌ عن مستقبل أفضل، يتبعه صمتٌ يقطعه سؤالٌ خفيف لكنه قاسٍ: “طيب! شو الجاي؟”. فالسوريون اليوم بين نصرٍ لم يكتمل ومرحلة انتقالية لم تتضح معالمها. وحتى الفرح نفسه يحتاج إلى يقين كي يعيش، ونحن لم نصل بعد إلى اليقين.
في طريقي إلى عملي، تمرّ أمامي طوابير طويلة بعضها للحصول على الخبز، بعضها للبنزين، وبعضها للحصول على أوراق حكومية لم نعتد يوماً أنها يمكن أن تُستخرج من دون خوف. أشاهد الوجوه بدقة؛ وجهٌ يشعر بالراحة لأنه لم يعد خائفاً من المُخبر، ووجهٌ يشعر بالخوف لأنّ غياب المُخبر لا يعني حضور العدالة! وجوه ثابتة ظاهرياً لكنها تتحرك من الداخل مثل شجرة يتمايل جذعها بفعل الريح من دون أن تنتبه العين.
في البقالية، أسمع حديث رجلين! الأول يتحدث بحماس عن أن البلاد قد ولدت من جديد، والثاني يهمس بأن الأبناء غائبون، الأراضي محترقة، وماذا يخبئ لنا الغد غير واضح. هذه العبارة تُشبه حال السوريين الآن؛ بين حلم الولادة الجديدة ورعب الموت المبكر للفرص.
حتى البيوت نفسها تغيّرت! في الأمسيات حين أجلس قرب المدفأة التي بالكاد تعطي دفئاً، أسمع أصوات الجيران. ضحكات أكثر من قبل، لكنها ضحكات قصيرة وكأن الجميع يخشى أن يضحك بصوت مرتفع فيعاقبه القدر على جرأته في الفرح. أحاديث عن الغلاء، عن فرص عمل قد تظهر أو لا تظهر، عن شائعات تتطاير كل يوم، وعن خوف من غدٍ لم يُكتب بعد. هذه التفاصيل الصغيرة ليست ترفاً سردياً، إنها الواقع الذي يعيشه الملايين، واقع لا يعبّر عنه بيان سياسي أو مقال تحليلي. الواقع يتجسّد في كيف يشرب الناس قهوتهم، كيف يشدّون معاطفهم، كيف يتنفسون وهم يعبرون الحواجز التي لم تختفِ بعد.
وسط هذا كله لا يمكن للإنسان أن يفصل نفسه عن الثقل الداخلي الذي يحمله. أجد نفسي أعود إلى الله أحياناً بقوة تشبه تعلق الغريق بقارب نجاة، وأحياناً أبتعد عنه كأنني أعيش يوماً عادياً لا يستحق الدعاء. هذه المفارقة تُرهقني، لماذا أكون قريبة منه في الأزمة والفرح وأبقى على مسافة في الأيام التي لا تحمل حدثاً كبيراً؟ ربما لأنّ النفس البشرية تتعلّق باليقين، ونحن اليوم نعيش في منطقة يتقلّب فيها اليقين كالوميض. لا نحن في انهيار كامل ولا نحن في قيامة واضحة.
العلاقة مع الله في هذه المرحلة تشبه علاقتي بهذا القميص؛ أحتاجه، ألجأ إليه، لكنه أحيانا يضغط على رقبتي، يذكّرني بأنني لا أزال خائفة على الرغم من كل محاولات الطمأنة. أشعر بأنني أريد علاقة معه لا تتحرك بتقلّبات السياسة، ولا ترتجف مع ارتجاف الشوارع. أريد علاقة ثابتة، تواجداً يومياً، دفئاً لا يرتبط بطارئ ولا بانفراج.
وفي الظهيرة حين أجلس وحدي لتناول الغداء، أفكر في أنّ السوريين يعيشون اليوم في فاصل تاريخي لم يُختبر من قبل. الانتقال من الخوف إلى ما بعد الخوف ليس انتقالاً بسيطاً. يحتاج إلى وقت وإلى إعادة ترتيب داخلية تشبه إعادة ترميم بيت تداعت جدرانه. فكيف للروح التي عاشت تحت الظلم والخوف والحرمان أن تتحول فجأة لتصبح مطمئنة؟ كيف للإنسان الذي فقد ثقته في السلطة وفي القانون، وأحياناً في الناس أنفسهم، أن يصدّق أنّ الآتي قد يكون مختلفًا؟ هذه العملية ليست سياسية فحسب، بل نفسية وعاطفية وروحية.
وحين أعود إلى البيت ليلا أعلّق قبّة الخنق على الباب. ألمس قماشها وأدرك أنها أكثر من لباس. هي رمزي الشخصي لما نمرّ به الآن. تلفّ عنقي لتحميني من البرد، لكنها تضغط قليلاً، كأنها تقول لي: الأمان ليس حاضراً بالكامل، عليكِ أن تبني دفئكِ الداخلي بنفسك.
أفكر عندها أنّ سوريا قد تغيّرت بالفعل، لكنّها تغيرت بطريقة تجعلنا نتلمّس الدفء بحذر. النصر ليس ورقة تُعلّق على جدار بل شعور يحتاج سنوات ليترسّخ. والقلق ليس علامة ضعف بل علامة على أنّ أرواحنا تبحث عن مكان تستقر فيه أخيراً. المرحلة الانتقالية ليست طريقاً ممهداً، بل أرضاً رخوة نسير عليها بخطوات خفيفة كي لا نوقظ ما تحتها.
والإيمان بالله، بالحياة، وبالمستقبل يحتاج في هذه المرحلة إلى عناية خاصة. يحتاج إلى حضور في الأيام العادية أكثر من حضوره في الكوارث. يحتاج إلى أن يرافقني كما ترافقني قبّتي الخنق، ولكن من دون أن يخنق، من دون أن يضيّق على الروح التي تبحث عن فسحة. أريد أن أتقرب من الله لا لأني أخاف الآتي، بل لأني أحتاج إلى أن أتمسك بشيء ثابت في عالم يتبدل كل يوم
ربما في نهاية كل هذا، سأكتشف أن قبّة الخنق ليست رمزاً للخنقة وحدها، بل هي رمز للدفء الذي نحاول أن نحفظه داخلنا ونحن نمرّ فوق أرض باردة، وللخوف الذي لا يزال يتلبّسنا على الرغم من أننا هزمنا جزءاً من ظلاله، وللرجاء الذي لا يموت مهما تأخر.