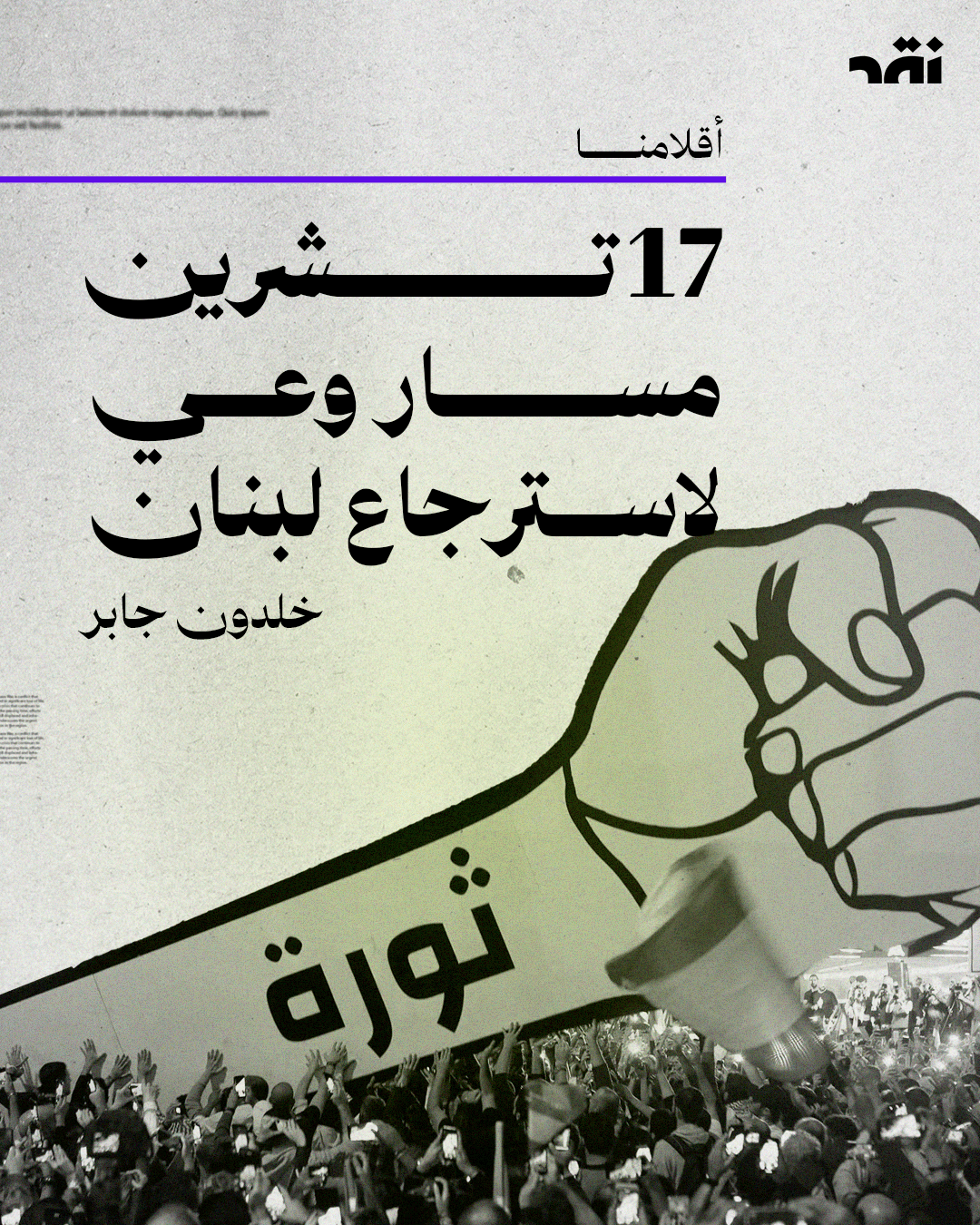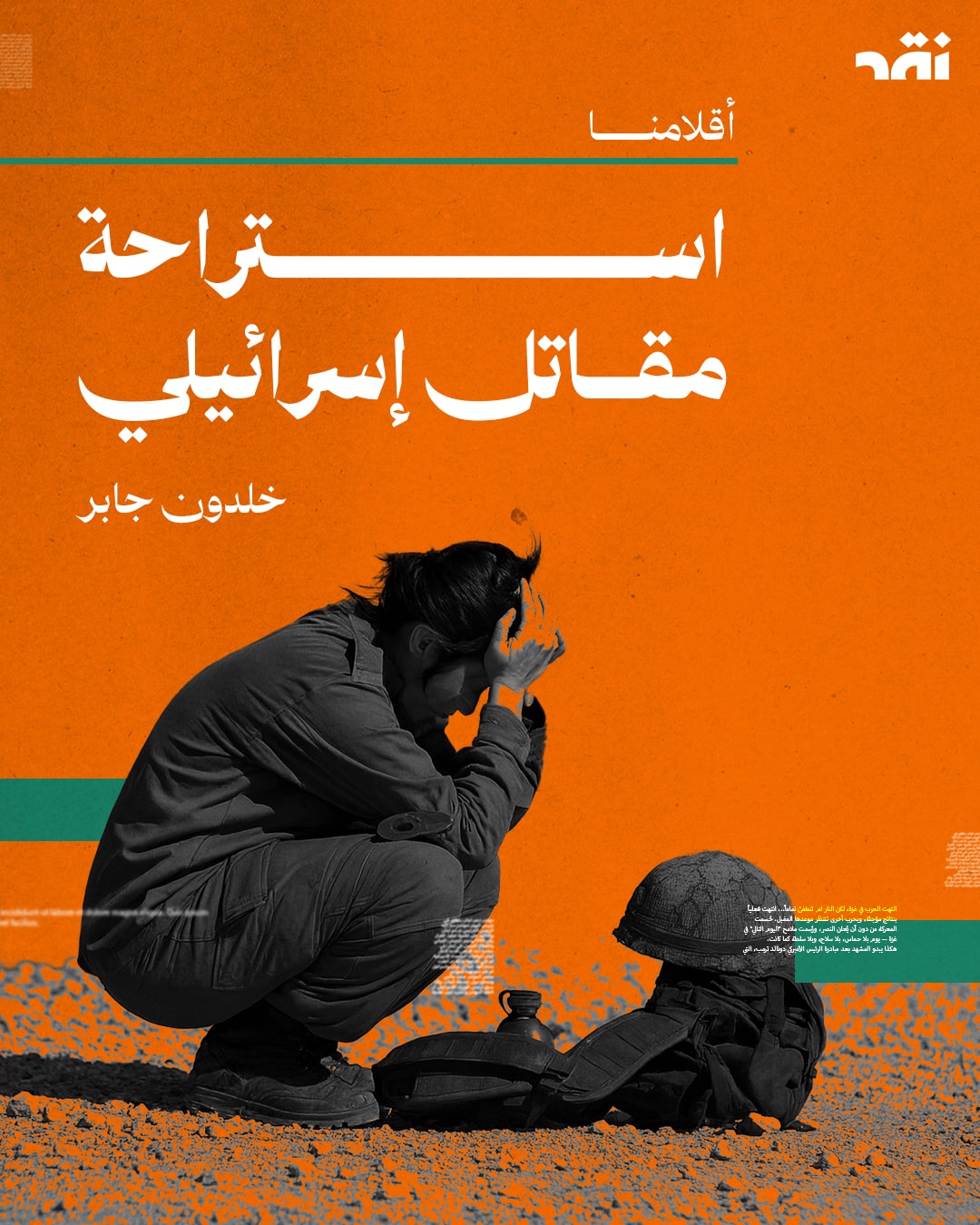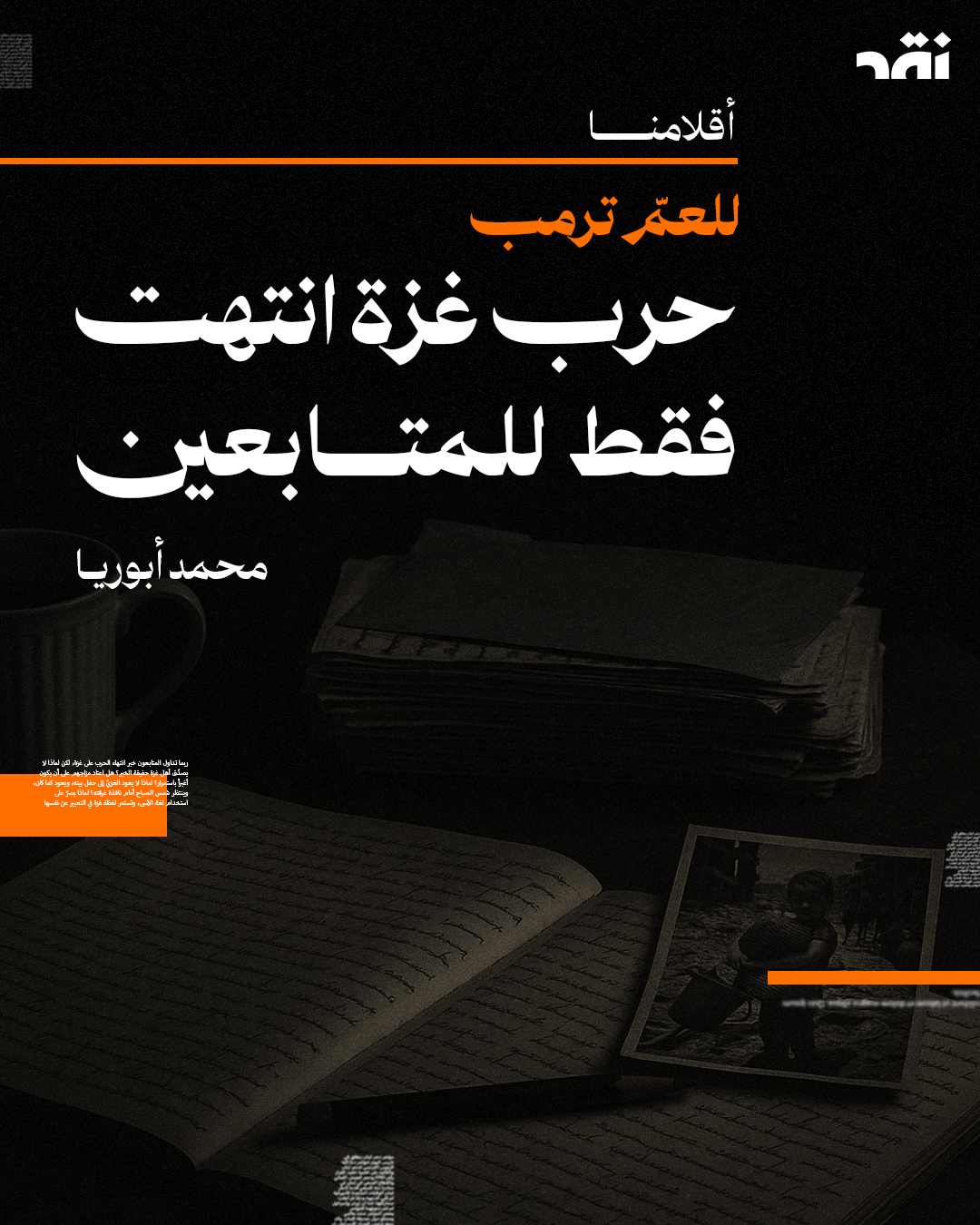
24 Oct 2025
Like this post
ربما تداول المتابعون خبر انتهاء الحرب على غزة، لكن لماذا لا يصدّق أهل غزة حقيقة الخبر؟ هل اعتاد مزاجهم على أن يكون أغبراً باستمرار؟
لماذا لا يعود الغزيّ إلى حقل بيته، ويعود كما كان، وينتظر شمس الصباح أمام نافذة غرفته؟
لماذا يصرّ على استخدام لغة الأسى، وتستمر لفظة غزة في التعبير عن نفسها بمفردات الغياب والضياع والموت؟ ها قد انزاح حاجز نتسريم، وصار بين الجنوب والشمال شارع، فلماذا تظهر غزة مدينة أشباح؟
ترمب يلوح أفقُه في سماء الحل والوفاق والسلام، فلماذا لا يزال مرحاض أهل الخيام بغيضاً؟ ولماذا لا تعترف الذباب بهواء الحل وتترك فضاء الخيمة وترحل؟
أصدقائي الأعزاء، مشيتُ ناحية غزة في خطوة هي الأكثر عبثية في حياتي، إذ أستند على معرفةٍ قديمة بأن بيتي قد صار ركاماً، ومع ذلك مشيتُ على قدماي 20 كيلو متر، لا لشيء غير أن أحظى بصورة الخراب طازة… لا حماسة تقرأها في صفحات وجوه العائدين، لا لهفةً تركض قبل عيونهم، وكأنهم يمارسون روتيناً معتاداً: تفقد حصتك من الخراب، حصتك الدوريّة، واستعد لتشردٍ مستمر!
عبرتُ من شوارع ظننتني لا أعرفها، لكنني أعرفها، ما فائدة أن تصف الخراب مرةً أخرى؟ هذه المشاهد أعرفها جيداً، فقد عاينت سقوط الشمال أمام عيني، فلم أنزح في المرة الأولى، شكل الدمار واحد؛ ولا فائدة من أن تبكي مرتين على جثةٍ واحدة.
تابعت طريقي، وتخطيت مدينة غزة، ومشيت ناحية مخيم جباليا؛ لأعاين خراب بيتي، وأعرف حصتي من الدمار… قاربت على الوصول، ماشياً في شوارع غبت عنها نصف سنة، تركتها عامرةً بالمباني، ولكنني عدت أراها ككف، عفريتٍ، مبسوط على مساحته مسحوق البيوت. صحراء برمل أصفر، يخشاها الكلب الضال، ويستوحش فيها الذئب الضائع!
وصلت حارتي التي لا تمدّ لحارتي بصلة، أصوات الرصاص ساخنة، الدبابات على مرأى عيني، الرافعات القاتلة -لا عليكم هذه حصتنا من الحداثة، آلات قتل متطورة- يا ربي! ألسنا في هدنة، والعم ترمب تكفل في السلام؟
بل هذا “الخط الأصفر”.
وماذا يعني الخط ’الزفت’؟
لا أحد يعرف، هو مبرر القتل المستمر لأي غزيّ لا يتوافق مع مزاج الجنود الذين لايزالون يبتلعون نصف غزة. نعم يا صديقي لا يزال نصف غزة في أيدي الجيش، ولا يزالون يقطّعون غزة إرباً بأسنانٍ ملونة، وبطيخة “أبو الفراجين” الممثل الكوميدي لا تزال تتعرض للتقسيم والتقطيع حتى بتنا في فسيفساء من المأساة، تبزقنا الجغرافيا على مدّ التاريخ.
تسللت إلى حطام بيتنا، لا شيء فيه قائم، ولا شيء فيه يصلح لأن يستصلح مرةً أخرى، الجو الملغوم بالتوتر، والدبابات التي تحاصر أفقي لم يسمحا لي بلحظات الحسرة والوداع، فلم أستطع نعي منزلي، ولا حتى تحسس جدرانه المحطمة إذا ما كانت تحمل شيئاً لتقوله لي قبل أن ترخي جيدها لنصل الفناء، ولكن كل ما فعلته، هو النظر في السماء، ومخاطبة الخيمة: عزيزتي، لستِ مرحلة مؤقتة، بل أنتِ مصيري، وأنا مصيرك.
نشلتُ كتابين من بين الردم، وحملتهما عائداً إلى جنوب الوادي، وحيداً، تاركاً خلف ظهري مصطلحات لأشياء لا تنعكس على غير ذاكرتي الثقيلة. أعبّر مجدداً على طوابير المياه، وعن أطفال المفترقات، وعن بائعي أكياس الماء العطشى، وعن نساءٍ لا يتسترن بغير أقمشة الخيام من الموت والشمس والعري والأنوثة الضائعة… متسائلاً إذا ما كان ترمب يجيد قراءة ما تخطه المأساة على عيون الفتيات اليتامى، أو إذا ما كان يجيد تقديم خبز السلام من عجن الضحايا بحبر القمم والتصريحات.
أصدقائي، انتهت الحرب للمتابعين، لكنها مستمرة في غزة، ينامون جوعى كالعادة، يعيشون على الأرصفة، ينتظرون طويلاً على طوابير المياه، يناجون كل كائنات الأرض من أجل تصريح سفر للجرحى، ويناجون لمعرفة أجوبة مرتجفة عن مفقودين كثر لم يقبل بهم يقين الموت، ولم تحتويهم الحياة.
غزة التي نعرفها، لا تزال غائبة، وبعيدة، ولا تتأتى بغير أوصاف العذاب.
فيا عمي ترمب دخلتُ مرحاض البهائم قبل خطة السلام، ولا أزال أستخدم مرحاض البهائم بعد خطة السلام، فأين ذلك السلام الذي لا يضمن لي جلسة مرحاض هادئة وآدمية؟