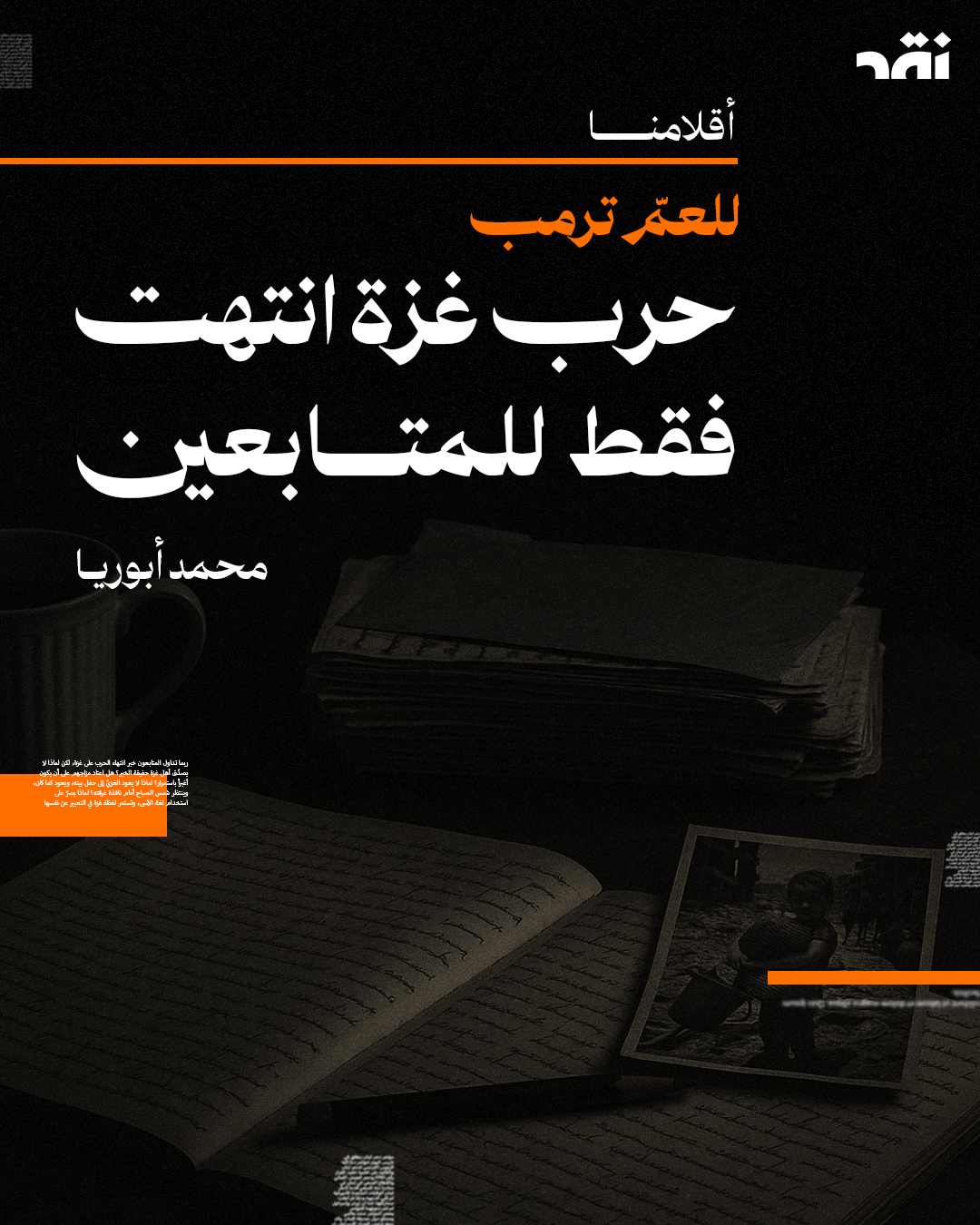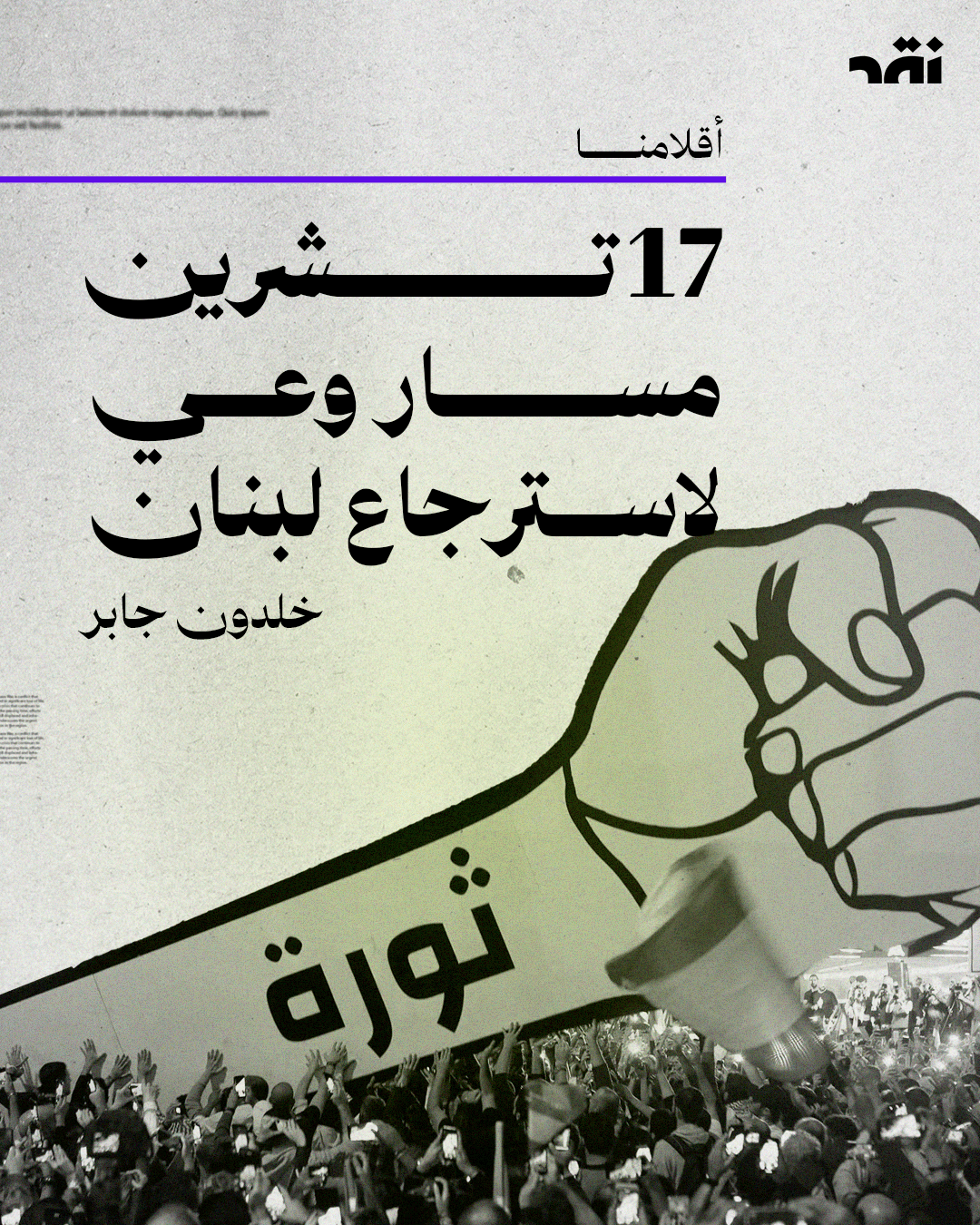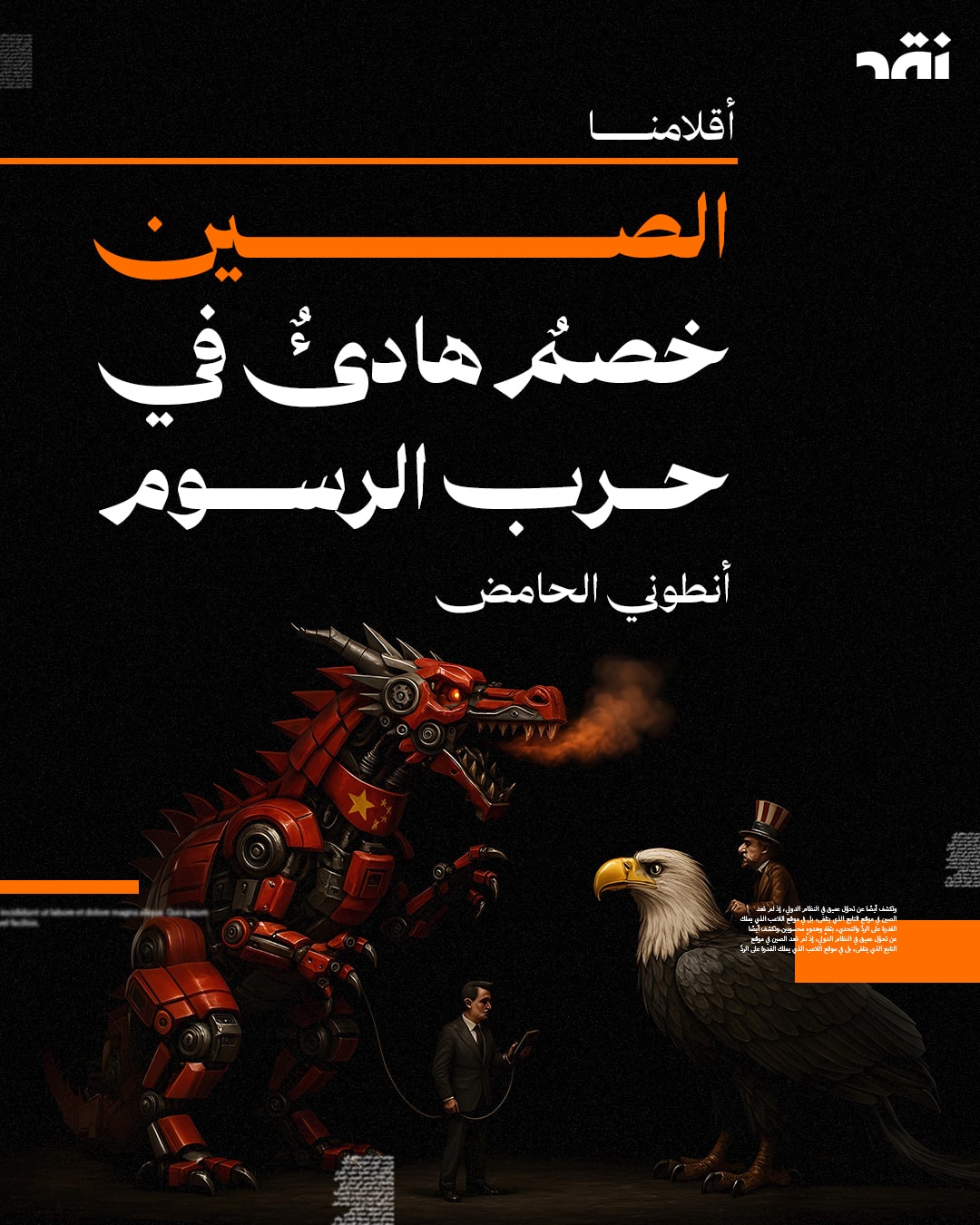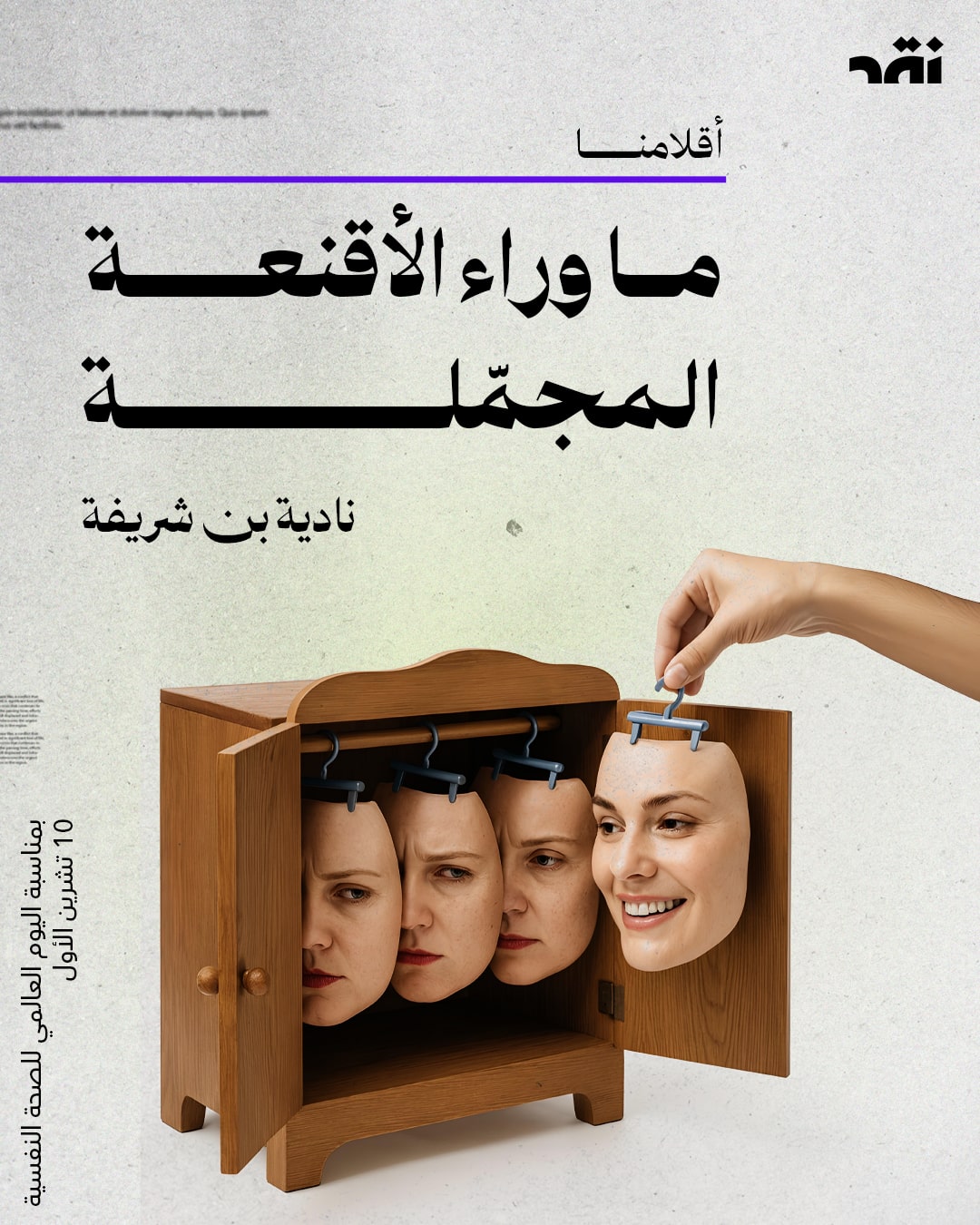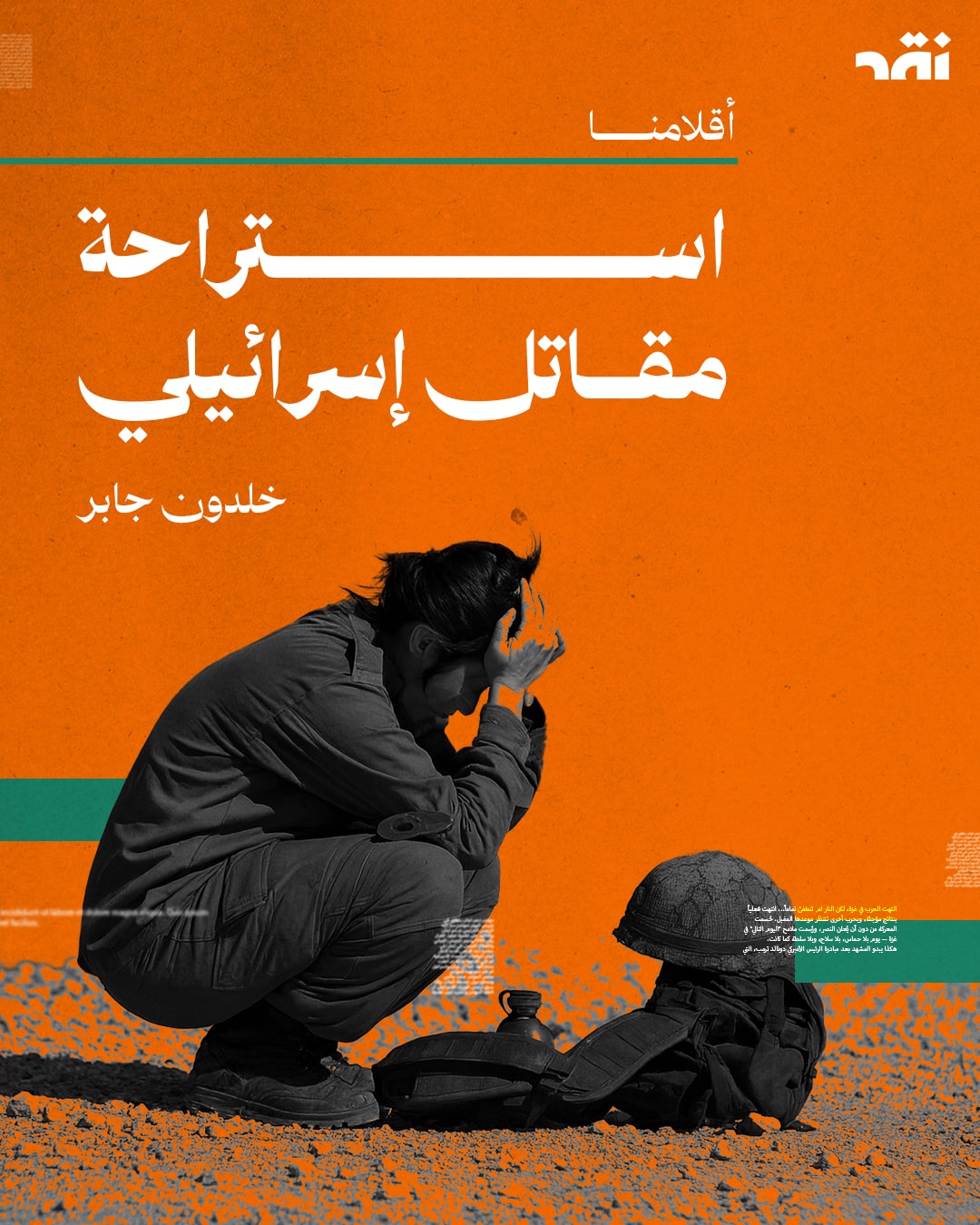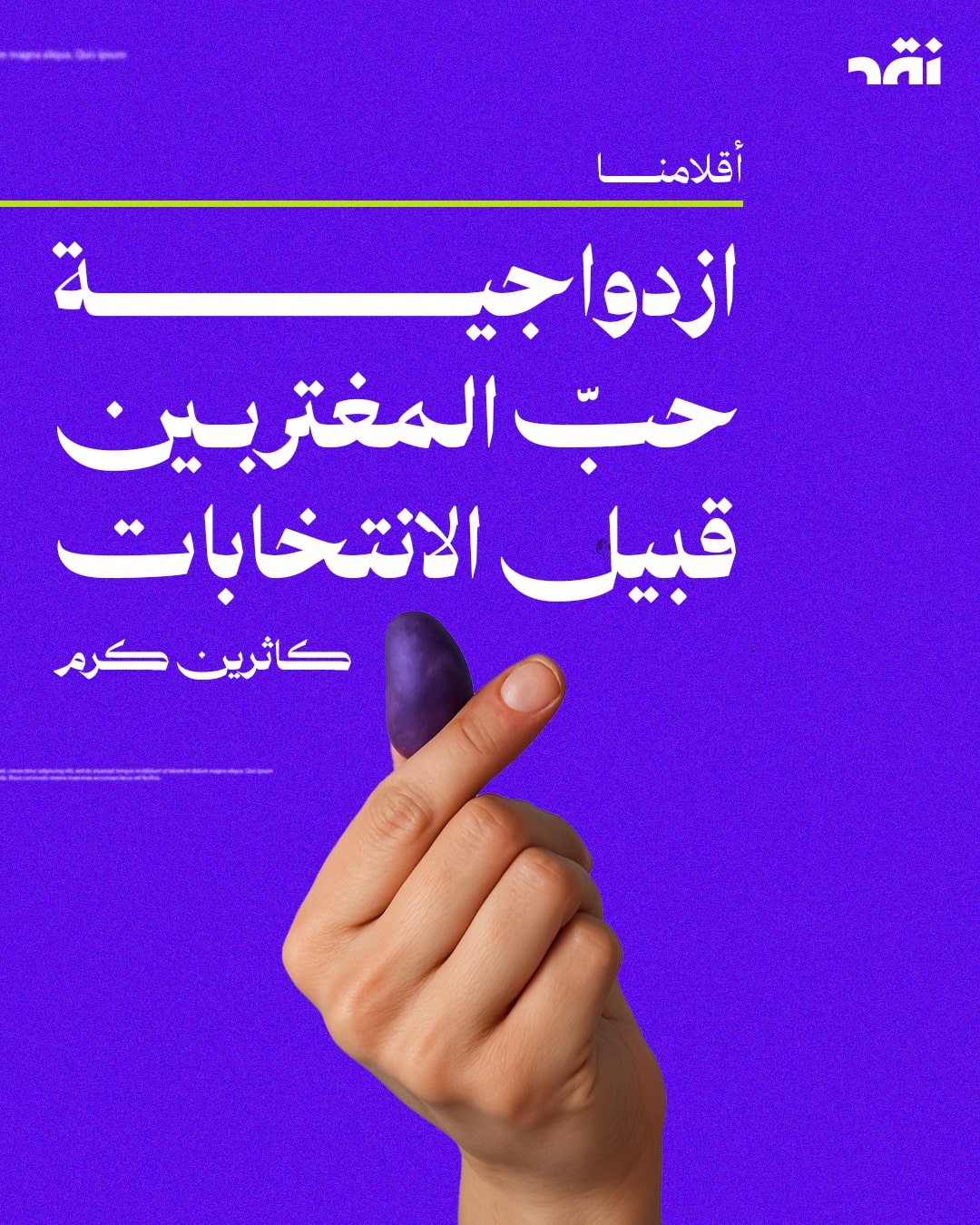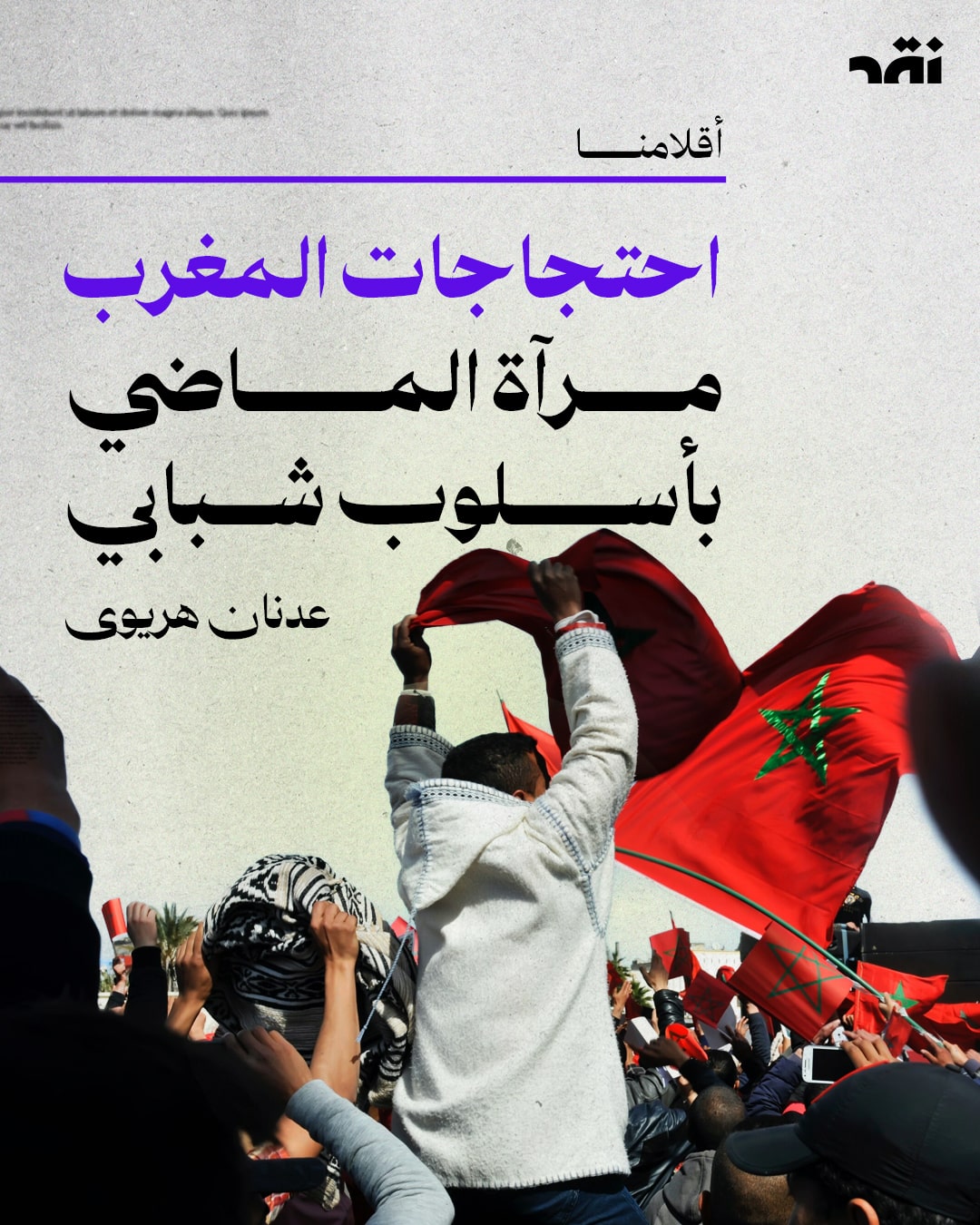
25 Oct 2025
Like this post
بعد أكثر من أسبوعين على نزول شباب من “جيل زد” إلى الشارع في مدن مغربية عدة، هاتفين بإصلاحات هيكلية في الحقلين السياسي والاجتماعي-الاقتصادي، أجدني أكتب مقاربتي الشخصية الأولى لهذه اللحظة الحساسة. وبقدر ما يفرض التحليل قدراً من التريث، تظل هذه السطور تأملات أولية ومحاولة قراءة من خارج الحدث لدينامية شبابية قيد التشكل.
صحيح أن تشابك الفاعلين والسياقات يُعقد استشراف مآلات هذا التحرك، غير أن ما يكاد يجمع عليه المراقبون هو أن الساحة أفرزت فاعلاً جديداً خرج من رحم منصة رقمية لم تكن في بؤرة رصد الباحث ولا ضمن أدوات المراقبة التقليدية لدى المسؤول الأمني.
موجة احتجاجية جديدة بقيادة الشباب
شهد المغرب، منذ أواخر أيلول 2025، موجة احتجاجات شبابية واسعة عُرفت بـ”جيل زد 212″. وكانت الشرارة الأولى لانفجار موجة غضب عارمة متمثلة في وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بأكادير، إذ تزامن ذلك مع انتشار دعوات احتجاج عبر منصة “ديسكورد”، فتحول خادم صغير (أقل من ألف عضو عند الانطلاق) إلى مجتمع رقمي يضم أكثر من 150 ألف شاب خلال أيام. وخرجت حشود في مدن الرباط والدار البيضاء وغيرها تطالب بإنقاذ قطاعَي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، في واحدة من أكبر التعبئات الشعبية منذ 2011.
تعكس المطالب المرفوعة عمق الأزمة الاجتماعية والتنموية المتمحورة حول ثلاثة محاور تعليم جيد، رعاية صحية متاحة، وعيش كريم. وتصدّر المشهد هتاف “الملاعب هنا، فأين المستشفيات؟”؛ احتجاجاً على أولويات الإنفاق. ففي حين خُصصت غطاءات مالية مهمة للبنية التحتية واستضافة تظاهرات كبرى (كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025)، تتدهور خدمات المستشفيات والمدارس. ويطالب الشباب بخفض كلفة المعيشة وتوسيع فرص العمل مع بلوغ بطالة الفئة 15–24 عاماً، نحو 35.8%، وبمحاسبة المسؤولين عن الفساد وتحميل الحكومة كلفة التردّي.
ويزيد التفاوت الاجتماعي والمجالي الحادبين مدن تستقطب الاستثمارات وأخرى داخلية مهمشة من حدة الاحتقان. في هذا السياق، أعاد “جيل زد” تذكير الدولة بأن النموذج التنموي ذي النزعة الليبرالية المعتمِد على الاستثمار الخاص والمشاريع الضخمة يعاني خللاً وظيفياً واضحاً، ولا ينسجم مع توقعات مواطن تربّى على أن الدولة هي الضامن الأساسي للخدمات العمومية.
أزمة ثقة متجددة في الأحزاب والمؤسسات
اللافت أنّ الحراك الشبابي الراهن، على حداثة سن من ينتمي له، أعاد إنتاج النسق ذاته. لقد تجاوز قنوات الوساطة التقليدية والعمل السياسي عبر الأحزاب والنقابات. وهذه ليست المرة الأولى التي يختار فيها المواطنون الشارع مسرحاً للتعبير الجماعي. ففي العام 2011 قادت حركة 20 شباط مظاهرات حاشدة رفعت مطالب جذرية من حلّ الحكومة والبرلمان إلى وضع دستور يجسد الإرادة الشعبية، واعتمدت تنظيماً أفقياً عبر منصة الفيسبوك وشبكات التواصل بعيداً من الأطر الحزبية. ثم تكرّر المشهد في حراك الريف بين 2016 و2017 عندما انتفضت مدينة الحسيمة ونواحيها ضد التهميش وطالبت بتنمية محلية هيكلية بقيادة ناشطين مستقلين مثل ناصر الزفزافي ومن دون غطاء حزبي أو نقابي. وعلى المنوال ذاته جاءت احتجاجات جرادة سنة 2018 عقب وفيات عمال آبار التنقيب عن الفحم الحجري، التي يُطلق عليها محلياً اسم “الساندريات”، حيث خرج الآلاف للمطالبة ببديل اقتصادي وفرص عمل تنهي الهشاشة المستدامة.
تكشف هذه السلسلة المتعاقبة من 2011 إلى 2025 عن دينامية احتجاجية مستمرة في المجتمع المغربي. ففي كل بضع سنوات ينفجر الغضب من أسفل وخارج الأطر الحزبية والمؤسساتية، ويعود السؤال ذاته حول شرعية هذه المؤسسات وجدواها. ولا تضعنا التقديرات سوى أمام فكرة مفادها أن انتفاضات 2011 وحراك الريف وما تلاهما تنبع من منطق واحد سيظل حاضراً ما لم تتخلله تغييرات سياسية واقتصادية جوهرية. وإذا لم تُعالَج جذور الأزمة فسنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها. لم يشذّ حراك “جيل زد” عن هذه القاعدة. فقد عبّر معظم الشبان المحتجّين عن سخط عارم تجاه مجمل الأحزاب السياسية، وردّدوا شعار “الشعب يريد إسقاط الفساد” بما يشير إلى تراجع شبه كامل في الثقة بالطبقة الوسيطة. وفي خطوة غير معهودة وجّه منسّقو الحراك رسالة إلى الملك محمد السادس يطالبون فيها بالتدخل المباشر عبر حلّ الحكومة القائمة وحلّ الأحزاب المتهمة بالفساد، وذلك باعتبارها عائقاً أمام تلبية المطالب.
وسبق هذا التوجّه هتاف “الشعب يريد تدخّل الملك” في شوارع عدة، وهو ما يوحي بانتقال الرهان مباشرة نحو المؤسسة الملكية وتخطّي الحكومة والبرلمان والأحزاب بوصفها مؤسسات عاجزة عن الاستجابة. وتدعم مؤشرات الثقة هذا المزاج العام، إذ يفيد استطلاع للمركز المغربي للمواطنة بأن قرابة 95% من المواطنين لا يثقون بالأحزاب. وهكذا تتضح أزمة مؤسسات تتفاقم بمرور الزمن وأزمة وساطة يعاد تدويرها مع كل جيل جديد. والمؤسف أن ردود فعل جزء من الطبقة السياسية لا تزال قاصرة عن استيعاب الدرس، فقد صدرت تصريحات رسمية فُهِمَت على أنها إنكار أو استخفاف بحدّة الأزمة فزادت الفجوة اتساعاً بدلاً من أن تُطمئن الشارع.
من “جيل فيسبوك” إلى “جيل زد”: ماذا تغيّر؟
إذا كان العزوف عن الأحزاب ورفض لغة الخشب سِمة قديمة في سلوك المواطنين، فإن السؤال عن الجديد الذي يحمله حراك جيل زد يظل مطروحاً بإلحاح. والجواب ليس يسيراً، وأي استعجال في التحليل قد يقود إلى استنتاجات مضللة.
يتميز جيل زد بخصائص تفصله عن جيل 2011 الذي اعتمد أساساً على فيسبوك. هذا الجيل تربّى في بيئة رقمية أكثر كثافة وترابطاً مع منصات مثل ديسكورد وتيك توك وإنستغرام، وهو أقل ارتهاناً للولاءات الأيديولوجية الكلاسيكية. تنظيمه أفقي ولا مركزي، ويستمد زخمه من قدرة عالية على الانتشار في الفضاء الافتراضي، وظهر ذلك جلياً في توسّع مجموعات ديسكورد من بضع مئات إلى مئات الآلاف خلال أيام قليلة. كما أنه جيل ذو أفق عالمي واسع، يرى أقرانه في مناطق مختلفة من العالم من نيبال إلى أوروبا يواجهون المشكلات نفسها من فساد وبطالة وانسداد في الفرص، فيزداد يقيناً بأنه ليس وحيداً في المعاناة ولا في قابلية التغيير.
يبقى السؤال حول ما الذي تبدّل الآن مفتوحاً أمام نقاش مشروع. قد تكون جرعات الإحباط قد تراكمت إلى حد الطفح بعد صدمات متعاقبة بدأت بالجائحة وتلتها موجات الغلاء العالمي، فأصبح هذا الجيل أكثر استعداداً للمخاطرة بالنزول إلى الشارع. ويرى آخرون أن غياب التحول الملموس منذ 2011 رسّخ قناعة لدى الشباب بأن الإصلاح التدريجي مجرد شعار وأن تجاوز الأساليب القديمة يتطلب صدمة كبرى أو قطيعة.
وعلى الرغم من رصانة هذه القراءة، لا يزال الوقت مبكراً لتقديم تحليل قاطع وحاسم. الحذر واجب حتى لا نقع في تبسيط ظالم لجيل زد ودوافعه. فقد علمتنا تجربة جيل فيسبوك سنة 2011 أن التفاؤل بقدرة حركات شبابية غير مؤطرة على إحداث تغيير بنيوي قد يصطدم بجدار توازنات سياسية صلبة. فقد أشعلت حركة 20 شباط شرارة إصلاحات مهمة شملت دستوراً جديداً وانتخابات مبكرة، لكنها انحسرت بعد نحو عام ولم تُحدث تحولاً جذرياً على المدى البعيد، وانتهى كثير من ناشطيها بين المتابعات القضائية والتهميش على هامش اللعبة السياسية. وفي الحاضر القريب لا يبدو شباب جيل زد راغبين في إعادة السيناريو نفسه، إذ يبدون أكثر تحدياً بحسب شهادات من ساندوا هذا الحراك، كما يوحون بأنهم استوعبوا دروس العقد الماضي ويعملون على تفادي أخطاء البدايات الأولى.
بين الشارع والدولة: أي مخرج للأزمة؟
مع استمرار الاحتجاجات، وجدت الدولة المغربية نفسها أمام معادلة صعبة. في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 13 تشرين الأول 2025 دعا الملك محمد السادس إلى تسريع برامج التنمية في الصحة والتعليم واستجاب جزئياً للغضب الشعبي حين أكد أولوية الملفات الاجتماعية، غير أنه لم يُشر صراحة إلى مطالب المحتجين. بدت الرسالة الضمنية واضحة، ومفادها أن الإصلاح ينبغي أن يتم عبر المؤسسات الدستورية القائمة من حكومة وبرلمان وأحزاب. وفي السياق نفسه تبنت الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش نبرة تصالحية قبل الخطاب وبعده، فأعلنت استعدادها للانخراط في حوار شفاف وتقديم مقترحات عملية لمعالجة الإشكالات، كما دعت وزارة الداخلية الشباب الغاضب إلى الحوار داخل المؤسسات وفي الفضاءات العمومية قصد البحث عن حلول واقعية. في الجهة المقابلة تمسّكت حركة جيل زد 212 بمطلبها الرئيسي المتمثل في رحيل الحكومة وحل البرلمان وتنظيف المشهد السياسي من الوجوه التي فقدت ثقة المواطنين، وهو ما يعني رهاناً على تجاوز المؤسسات بدلاً من العمل داخلها وتطلعاً إلى تدخل مباشر من الملك بصفته رئيس الدولة لإعادة تشكيل الحقل السياسي.
وتبدو الصورة أقرب إلى إعادة إنتاج توتر قديم بين الشارع والمؤسسات ظهر للمرة الأولى سنة 2011 مع اختلاف في التفاصيل. في ذلك الوقت طالب الشباب بإصلاحات عميقة وتغييرات دستورية فجاء الرد باستفتاء على دستور جديد وإشراك فاعلين سياسيين جدد في الحكومة لامتصاص الغضب. أما اليوم فتتجه المطالب إلى إقالة الحكومة المنتخبة نفسها وتجاوزها نحو صيغة تواصل مباشر مع رأس الدولة، وفي الحالتين تطفو أزمة ثقة مزمنة بين المواطن ومؤسسات الوساطة يتم تدويرها في قوالب مختلفة من دون معالجة جذرية. يبقى السؤال المطروح حول المسار الممكن للخروج من هذه الدوامة.
قد يبدأ الأمر من داخل الأحزاب عبر ديمقراطية داخلية حقيقية تضع حدوداً زمنية لولايات الأمناء العامين بولايتين على الأكثر وتفتح المجال أمام تجديد دوري للنخب بدلاً من احتكار القيادة لعقود طويلة، وقد يتعزز ذلك بمواثيق أخلاقية تمنع ظاهرة الميركاتو الانتخابي المتمثلة في انتقال المرشحين بين الأحزاب بحثاً عن المواقع. ويمكن لهذه الخطوات أن ترسم نظرياً مشهداً سياسياً أكثر طمأنة للناخب الشاب الباحث عن بدائل، غير أن الأثر العملي يبقى موضع ريبة لدى الأحزاب نفسها لأنها تدرك أن تطبيق هذه القواعد قد يقلص قدرتها التنافسية وربما يهدد استمرارها التنظيمي، لذلك تتباطأ في التغيير الجدي.
وعند هذه النقطة تعود الحلقة إلى بدايتها، فلا إصلاح حزبي جذري ولا استعادة لثقة شعبية بمؤسسات الوساطة، ويظل الشارع المتنفس الأوضح للتعبير عن المطالب في انتظار خطوة نوعية تقطع مع منطق تدوير الأزمة وتفتح أفقاً سياسياً يستجيب لمعيارَي الفاعلية والمساءلة معاً.
استشراف المستقبل: بين الأمل والمجهول
في خضم هذه الصورة القاتمة يظل السؤال عن إمكانات الفتح السياسي قائماً. خبرة العقدين الماضيين في المغرب تُظهر أن المؤسسة الملكية تتدخل في اللحظات الحرجة من أجل تعديل كفّة التوازن، وحدث ذلك سنة ألفين وأحد عشر حين أُقِرّ دستور جديد وتدابير إصلاحية هدّأت الشارع نسبيا.
وفي اللحظة الراهنة يبدو أن صنّاع القرار قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى إجراءات جامعة تمنح الشباب إشارات طمأنة ملموسة وتخفّف حدة الاحتقان. المقصود هنا خطوات قصيرة المدى لا تكتفي بالرمزية فقط، إنما تترك أثراً محسوساً في حياة المواطن.
يمكن البدء بإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية على نحو واضح. تحويل جزء معتبر من الاعتمادات الموجهة للمشاريع الاستعراضية نحو الصحة والتعليم سيبعث رسالة مفادها أن الدولة تستمع لنبض الشارع. ويواكب ذلك برنامج استعجالي لصيانة المستشفيات وتجهيز أقسام الولادة وتخفيف كلفة الولوج إلى العلاجات الأساسية. وعلى مستوى المدرسة العمومية يمكن إطلاق خطة دعم مباشر للأسر الهشة وتوسيع خدمات النقل والمطاعم المدرسية، مع إعلان جداول زمنية دقيقة لإنجازات فصلية يتم الإبلاغ عنها دورياً للرأي العام. على الرغم من أن مثل هذه الالتفاتات السريعة قد لا تحل المشكل البنيوي، لكنها تُظهر نية سياسية جادة وتفتح نافذة لخفض التوتر. تحتاج الدولة في الآن نفسه إلى مقاربة تواصلية جديدة.
الخطاب الرسمي عندما يستعمل لغة تقنية جافة يوسع الفجوة مع جيل يفكر ويحتج عبر وسائط تفاعلية وسريعة. يمكن اعتماد استراتيجية مخاطبة متعددة القنوات تستثمر المنصات التي نشأ فيها جيل زد، وتعرض البيانات المفتوحة حول الميزانيات ومؤشرات الإنجاز، وتقرّ بالأخطاء بدلاً من إنكارها. الاعتراف لا ينقص من الهيبة في هذه الحالة لأنه يراكم رصيداً من الصدقية يصعب تحصيله بغير ذلك. كما أن إشراك فاعلين مستقلين من جامعات وهيئات مهنية ومؤسسات تقييم في مراقبة السياسات العامة سيؤسس لنمط مساءلة يخفف من شخصنة القرار ويعيد الاعتبار للمعايير. المشهد مفتوح على عدة سيناريوهات. قد نشهد مسار تهدئة مشروطاً بسلة إجراءات اجتماعية عاجلة يعقبه إصلاح سياسي مضبوط المراحل.
أو قد يتكرس في المقابل وضع المراوحة حيث تُعتمد مهدئات متفرقة من دون تعديل قواعد اللعبة. في هذا السيناريو نرى تغييرات تجميلية في الخطاب وبعض الإعفاءات الحكومية المحدودة وحملات تواصلية لا تعالج جوهر المطالب. تهدأ الشوارع أسابيع أو أشهر ثم تعود بزخم أقوى عند كل حادث رمزي أو ضغط معيشي جديد. تتآكل الثقة تباعاً، ويترسخ شعور باللامبالاة أو السخرية السياسية، وتصبح المنصات الرقمية أكثر حساسية للاحتقان بما يسهل التعبئة السريعة وغير المتوقعة. ويظل أسوأ الاحتمالات هو الانزلاق نحو مقاربة أمنية تُغلّب منطق الضبط على منطق السياسة، ما قد يؤدي إلى إضعاف الحقوق الدستورية وتوسيع المسافة بين المجتمع والدولة، ويخلق أثراً عكسياً يتمثل في رفع منسوب الغضب والاحتقان.
غالباً ما ينتج عن ذلك تدوير للأزمة بدلاً من إطفائها، إذ تتراجع قنوات الوساطة السلمية وتنكمش مساحات الحوار، بينما تتكاثر نقاط الاشتعال عند أول صدمة اجتماعية أو حادث مأساوي. يقف المغرب اليوم عند مفترق طرق حقيقي. الالتقاط الإيجابي لرسالة جيل زد سيعني قرارات شجاعة تعيد رسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أرضية المساءلة والتنمية العادلة. والاكتفاء بإخماد صوت الشارع من دون حلول مستدامة سيولد هدوءً خادعاً سرعان ما ينكسر مع موجة جديدة ربما أشد كثافة.
التاريخ لا يعيد نفسه إلا عندما نهمل دروسه، ولا يزال ممكنا تحويل هذه الأزمة إلى بداية تعاقد اجتماعي جديد يقطع مع إدارة الأزمات بالمقاربة الأمنية وبالمهدئات العابرة وينتقل إلى منطق التعلم والإقرار بالخطأ قبل الحديث عن أي محاولة بناء ثقة.