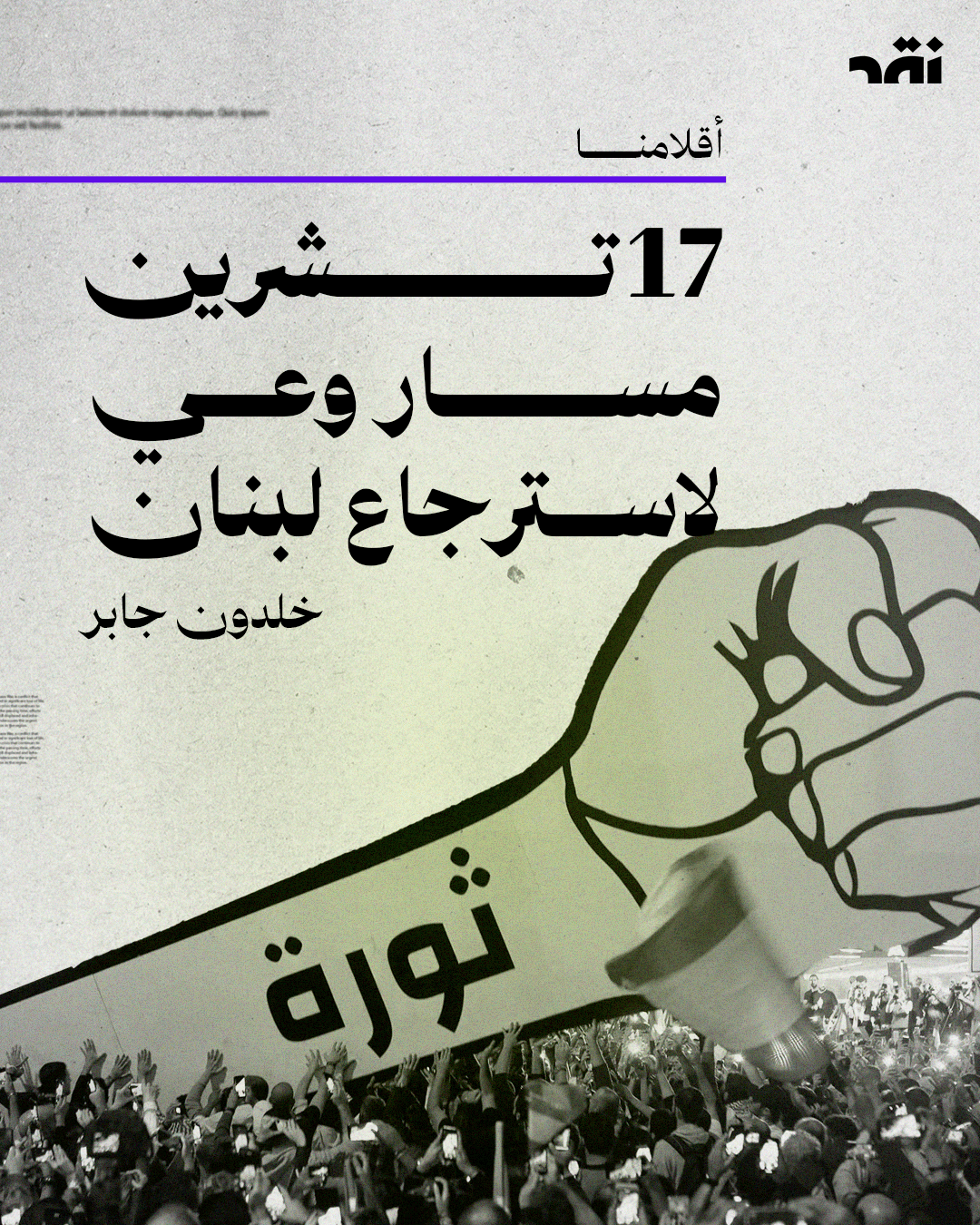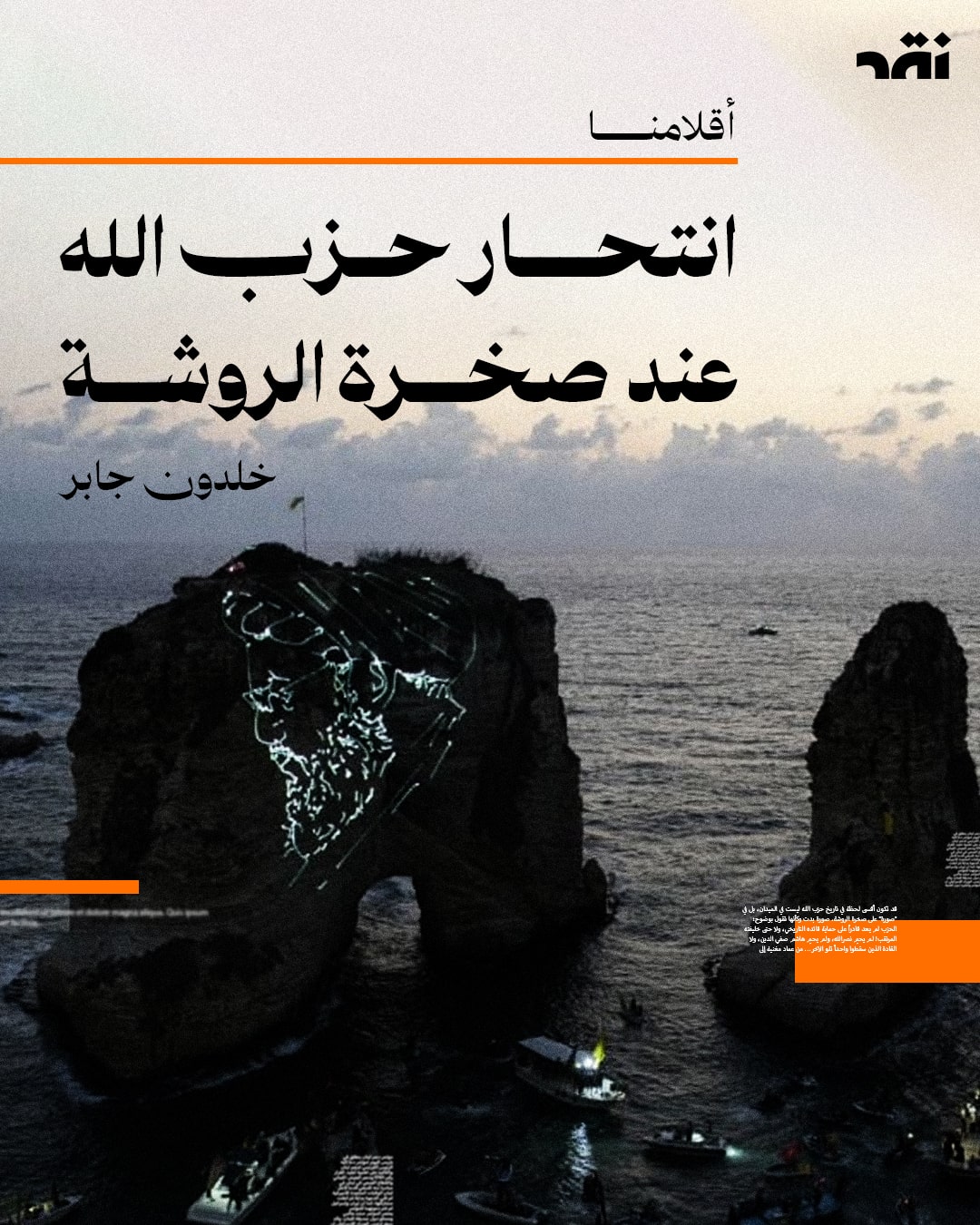31 Aug 2025
Like this post
هذا التقرير هو تفنيد للفيلم الوثائقي “سجنا رومية“، من إنتاج منصّة نقد بالتعاون مع مؤسّسة سمير قصير، شاهدوا التقرير الكامل هنا.
في الزنازين المظلمة المكتظة، هناك مَن ينام على الأرض الباردة لأن لا أحد تبرّع له ببطانية، وهناك من يضع مكيفًا فوق رأسه ويشرب قهوته يوميًا، كأن لا جريمة ارتكبها. في رومية، أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظًا، يتعايش نزلاء من طبقتين: واحدة مسحوقة ومعدومة، والثانية مرّفهة ومدفوعة الثمن.
هذا السجن، الذي أنشئ ليضم ألف سجين كحد أقصى، بات يضم وحده أكثر من ٣ آلاف سجين من أصل ٦٢٣٧ سجين في كلّ لبنان، بحسب إحصائيات “الدولية للمعلومات” حتى نهاية آب ٢٠٢٥. لكن الأرقام وحدها لا تكشف الحقيقة، بل تفاصيل الحياة اليومية هي التي تفضح وجهاً آخر للعدالة: وجهًا مشوّهًا بالمال والنفوذ.
“صرلي سنين هون، وقّفت عد الإيّام من زمان وفقدت الأمل إني إضهر لأن أصلاً ما معي وكّل محامي، لو عنا دولة عالقليلة كان القاضي استجوبني بعد هالسنين”
أبو سامي (اسم مستعار كما يلقّبه السجناء)، خمسيني من الضاحية الجنوبية لبيروت، موقوف منذ عامين ونصف بتهمة السرقة، لم تُجر له أي محاكمة حتى اليوم. يقول من خلف القضبان بصوت مبحوح:
“كل شي بدّك تدفع حقّه: من زيارة الطبيب، لكوب مي، للذهاب للمحكمة حتى السجين صار لازم يدفع ليستمع له القاضي”.
“كل شي بدّك تدفع حقّه: من زيارة الطبيب، لكوب مي،
للذهاب للمحكمة حتى السجين صار لازم يدفع ليستمع له القاضي”.
عدالة معلّقة ومحسوبيات بـ”الجملة”
في أحد الأجنحة، أكثر من ٢٤ سجينًا يتقاسمون مرحاضًا واحدًا (الصور مرفقة بالتحقيق). لا صابون، لا ماء ساخن، ولا علاج. المصابون بأمراض مزمنة كداء السكري أو الضغط لا يحصلون على أدويتهم بانتظام، ما يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات قاتلة.
أثناء إعداد هذا التقرير توفي السجين أسامة الجاعور (سوري الجنسية)، بسبب الإهمال الطبي حسبما تبيّن لنا استناداً إلى فحوصاته الطبية وشهادة باقي السجناء، مع العلم أن محاميه قدّم التماساً للمحكمة بتخفيض عقوبته بسبب وضعه الصحي المتدهور أو نقله إلى المستشفى بعدما أصيب بالشلل، إلّا أن القاضي رفض الطلب المقدّم دون تبرير الرفض.
وفاة أسامة تتزامن مع رفض مجلس الوزراء اللبناني قانوناً لتخفيف معاناة السجناء إنسانياً عبر منح عفو عام استثنائي (الصورة مرفقة بالتحقيق).
يخبرنا السجين (ح.ح.) أن أكثر من ٣٠ شخصاً يعانون من الجرب في مبنى “د” وحده بسجن رومية، حيث لا توفر الإدارة الدواء ولا حتى الماء الكافي للاستحمام. ولتزداد معاناتهم، جاءت الصيفية هذا العام مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث لا منفس للهواء ولا وسائل تبريد، ما يحوّل الزنزانة إلى بيئة خانقة تسرّع من تفشي الأمراض.
“بعد مية واسطة وبعد ما كشف عليي الحكيم بالمبنى الاحترازي، قبلوا إنو أهلي يجيبولي الدوا، ولليوم بعدني عم بتعالج وآثار الحبوب معلّمة بجسمي لأن ما في نضافة هون، حتّى المي للي بيعطونا ياها كلسية، والرطوبة دابحتنا… من وين ما بدنا نمرض ونموت؟”… يسأل (ح.ح.).
سجن رومية: مقبرة مكتظة
يعاني سجن رومية من أوضاع إنسانية بالغة السوء، تجعل من إعادة تأهيل السجناء أمرًا شبه مستحيل، وفقًا لإحدى المنظمات المتابعة.
فهذا السجن الذي أُنشئ عام ١٩٥٨ ليستوعب نحو ١١٠٠ سجين، تجاوزت نسبة الاكتظاظ فيه ٣٠٠٪ بحسب إحدى المنظمات المعنية، ما أدى إلى تدهور شديد في الظروف الصحية والمعيشية. المنظمة التي فضل رئيسها عدم الكشف عن اسمه تجنبًا للملاحقة، شددت على ضرورة إعادة تأهيل شاملة تشمل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات لضمان كرامة السجناء وحقوقهم الأساسية.
تؤكّد إحدى المنظمات أن الفروقات الطبقية داخل سجن رومية تعكس الواقع الاجتماعي خارجه، حيث يتمتع بعض السجناء بنفوذ مدعوم من جهات أمنية أو خارجية، يمكّنهم من السيطرة على حياة الآخرين. ويبرز دور “الشاويشية”، وهم سجناء نافذون يُفرضون كقادة غير رسميين داخل كل مبنى، ما يفاقم من صعوبة الإدارة ويزيد من معاناة السجناء العاديين.
العدالة منتقاة: فجوات قانونية وانتقاء!
في قلب العدالة اللبنانية، تختبئ فجوة مخيفة بين ما ينصّ عليه القانون وما يُمارس على أرض الواقع. وثائق وأحكام حصلت عليها المحامية فاديا شديد ونعرضها تباعاً في التحقيق، تكشف عن وجه قبيح لهذا التناقض: مماطلة منهجية في دعاوى مواطنين لا يملكون ظهرًا سياسياً أو نفوذاً، مقابل تسريع وانتقائية في التعامل مع ملفات من يتمتعون بالحماية أو “الواسطة”.
الانحياز لا يقف عند حدود التأخير، بل يصل أحيانًا إلى تجاهل كامل لشهادات المتضررين، حتى في قضايا تمسّ حرياتهم وحقوقهم الأساسية. واللافت أن هذه الممارسات تحصل رغم وضوح مواد القانون، لا سيما المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تُعد صريحة في تحديد سقف التوقيف الاحتياطي.
فوفقًا لنص المادة الحالي، لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف في الجنحة شهرين، قابلة للتمديد مرة واحدة في “حالة الضرورة القصوى”، بينما تُحدّد في الجناية بستة أشهر، يمكن تمديدها مرة واحدة فقط، بقرار معلّل ومبرر قانونيًا.
لكن على الأرض، يبدو أن هذه السقوف ليست أكثر من حبر على ورق. فبحسب الملفات التي قدمتها شديد، هناك موقوفون يقبعون خلف القضبان منذ سنوات دون محاكمة، في خرق فاضح للمادة نفسها، وبعلم تام من القضاة وأجهزة العدالة، الذين يُفترض أن يكونوا الحماة الأوائل للنصوص لا أول مَن ينتهكها.
في هذه الدوامة، لا يبدو أن القانون هو الحكم، بل الانتماء، والهوية، و”الضهر” السياسي أو الطائفي. أما أولئك الذين لا يملكون شيئاً سوى حقهم، فهم غالبًا ضحايا نظام يُفترض به أن ينصفهم.
في بعض المباني، حتى القوى الأمنية وإدارة السجن بكل عتادها وعناصرها لا تمتلك سلطة القرار بشكل حصري، إذ يُمنع أحيانًا دخول الضابط دون تفاوض مسبق مع الشاويشية حصريًا. فعلى سبيل المثال، مبنى المحكومين، الذي يضم بغالبيته سجناء إسلاميين، يتمتع نزلاؤه بعدة امتيازات، مثل خدمة الإنترنت (الواي فاي)، والاتصالات، والطعام وغيره.
السجناء متروكون لمصيرهم: لا طعام ولا ماء ولا دواء!
الطعام في سجن رومية، هو أقرب إلى الإهانة. وجبات لا تكفي طفلاً، ومياه غير صالحة للشرب. وعندما يشتكي أحدهم، يُقال له باختصار: “تحمّل، هيدا سجن مش أوتيل”.
تُظهر شهادة أبو سامي التي حصلت عليها منصة ‘نقد’ جانبًا من الواقع القاسي في سجن رومية، حيث تنتشر أمراض مثل الجرب والتهابات الرئة بسبب الرطوبة، وسط معاناة من سوء التغذية نتيجة قلة الطعام. وبحسب شهادات عدة، لا يتجاوز عدد الوجبات المقدمة وجبتين يوميًا، لا تكفي إحداهما شخصًا بالغًا، وغالبًا ما تكون غير صالحة للأكل.
“عيب الواحد يحكي هيدي نعمة لله بس الأكل ما بيتاكل، وما بياكلو أصلاً إلاّ الفقير والمحتاج أو أصحاب الجنسيات الأجنبية للي ما إلن حدا يزورن، إذا ما تحنّن عليهم الغني والمقتدر بالسجن ما عندن خيار تاني… حتّى الخبز للي بيجيبولنا ياه ما بيتاكل”، نقلاً عن أبو سامي.
يُقدّم لكل سجين يوميًا وجبتين: فطور وغداء. يتكوّن الفطور عادة من خبز مع مربى أو حلاوة، وأحيانًا فول، حسب تبرعات الجمعيات. أما الغداء فغالبًا ما يشمل بيضًا مسلوقًا أو بطاطا، أو رزًا أو برغلًا مع الفاصولياء. أما اللحوم والدجاج فتُوزع نادرًا أو تقتصر على الأعياد فقط.
بالمقابل، وفي جناح آخر من رومية، الصورة مختلفة تمامًا.
طوني (اسم مستعار)، وهو شاب ثلاثيني موقوف في قضايا مالية، يقول: “أنا مرتاح. عندي برّاد، تلفزيون، مروحة، وباقة إنترنت”.
السؤال الجوهري الذي يخطر على الأذهان أمام هذين المشهدين المتناقضين هو: كيف تحصل كل هذه التجاوزات على “عينك يا تاجر”؟ علماً أن الجواب بسيط: المال، وهذا ليس تحليلاً منّا أو اتهام عبثي، إذ توصلنا إلى هذه النتيجة بعد تحقيقات واستماع شهادات سجناء، ومختصين، ومتابعين لملف السجون…
كل ما لا تتيحه الدولة، يُتيحه السوق الموازي داخل السجن. يستطيع مَن يملك المال استئجار “زنزانة مريحة”، وشراء الطعام من “دكان السجن” بأسعار مضاعفة، والحصول على طبابة لا بأس بها، بل حتى ترتيب زيارة “خاصة” مع العائلة دون المرور بالإجراءات المعقدة التي يخضع لها الفقير.
“ما في عدالة جوّا. في سوق. كل شي إلو سعر. واللي ما بيقدر يدفع، بينسحق”، يقول أحد السجناء السابقين الذي “خاف” من ذكر اسمه لأن مَن يحكي الحقيقة أو يحاول التواصل مع الصحافة مصيره الانفرادي والحرمان من السوق إلى المحاكمة!
“التلفون سعرو ١٠٠٠$، للي بدو بيخبّر الشاويش بالمبنى، ودفع المصاري بيتمّ عبر شركة “wish money” أو “western union” لشخص خارج السجن، وتاني يوم من التحويل التلفون بيكون مع السجين”، يخبرنا السجين طوني.
في رومية، المال لا يُمنع، بل يتنكر. ورقة الـ100 دولار، وإن لم تدخل الزنزانة بصورتها الورقية، تجد طريقها بوسائل أخرى. فوفقًا لشهادات حصلنا عليها من داخل السجن، تم تطوير “نظام تحويل مالي” بديل، يتم عبر شركات تحويل الأموال في الخارج، لصالح أقارب أو أفراد من عائلة الشاويش، الذي يتولى “الإدارة الداخلية” غير الرسمية للجناح، بالتنسيق الكامل مع أحد الضباط داخل السجن.
هذا الضابط، بحسب الشهادات، يتقاضى حصته مقابل تمرير التحويلات، وتسهيل إدخال المواد أو الأجهزة إلى السجناء، وكأن شيئًا لم يكن. لا وجود لضوابط رقابية فعلية، بل كل شيء “يمشي” بالتفاهم، وحتى بالمداهمات، هناك قواعد غير معلنة.
هذا وكشف أحد الشاويشية (رفض إظهار اسمه)، في حديث خاص لنا، أن المداهمات لا تتم بشكل مفاجئ كما يُروَّج، بل يتم إبلاغه مسبقاً ليخفي ما يلزم. أما المفارقة الصادمة، فهي أن هذا الشاويش نفسه، وبعد أن يبيع هاتفًا نقالًا لسجين بموافقة الضابط، يقوم بالإبلاغ عنه، فيُصادَر الجهاز، وتُفرض عليه غرامة أو “رشوة جديدة” لاسترجاع ما يمكن استرجاعه.
ببساطة، يدفع الضحية مرتين… وفي كل مرة تُكتب المسرحية بغطاء قانوني زائف.
الفساد يبدأ من الداخل: الشاويش والضابط
يشكو اللبنانيون في الخارج من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة، أما داخل السجون فهذا المشهد أصبح مألوفًا ومتكررًا. تخيّلوا فقط أن هاتفًا يُمكن شراؤه خارجيًا بثمن ٣٠٠ أو ٤٠٠ دولار يُباع داخل السجن بأكثر من ألف دولار، ليس بسبب زيادة السعر فقط، بل لأن هناك “إكراميات” تُدفع بدءًا من الشاويش وحتى الضابط!
في حديث مع ١٠ سجناء داخل سجن رومية، إلى جانب محامين وجمعيات حقوقية، كشفت المصادر أن الضباط هم الوحيدون الذين لا يتم تفتيشهم عند دخول السجن. إدخال المخدرات أو الهواتف غير ممكن دون علمهم، فهم يتقاضون رشاوى لقاء تمرير هذه الصفقات بالتنسيق مع شاويش كل مبنى، لأن رواتبهم المتدنية لا تكفي حتى منتصف الشهر، مما يدفعهم للانخراط في صفقات مشبوهة تعرّض حياة السجناء للخطر.
حسب وثائق وتسجيلات صوتية، أكّد السجناء أن كل حالة وفاة تُسجّل على أنها “نوبة قلبية” هي في الواقع جرعة زائدة من المخدرات. هذا في ظل واقع مرير، حيث يُمنع الأهالي من إدخال الطعام للسجناء، بعد أن اكتُشف أن بعضهم كان يُخبئ مواد ممنوعة بداخله. حتى الملابس لا تدخل إلا بعد غسيلها من قبل إدارة السجن، فما هو السر وراء تسريب المخدرات والهواتف؟
الجواب يكمن في الفساد المستشري داخل السجن، حيث يتحوّل السجناء إلى ضحايا منظومة معقدة من الرشاوى والصفقات السرية التي لا تلتفت إلى صحة أو حياة المحتجزين، بل تُغذي حلقة من الانتهاكات المستمرة التي تزيد من مأساة هؤلاء البشر المنسيين خلف القضبان.
شهادات قانونية تفضح ما وراء القضبان
في تسجيل مصوّر، يكشف المحامي أشرف الموسوي تفاصيل صادمة عمّا يجري خلف القضبان، حيث تتحوّل الزنزانة إلى ساحة مفتوحة للبيع والشراء، ويتحوّل السجين نفسه إلى ماكينة نقدية تدفع لتعيش، وتدفع لتحمي نفسها، وتدفع لتنال أبسط حقوقها.
الرشاوى لا تُقدَّم تحت الطاولة فقط بحسب الموسوي، بل تُدار أحيانًا بشكل منظم بين بعض الضباط وعناصر الأمن، وفقًا لما يظهر في الفيديو. الولاء لا يكون للقانون أو للرتب، بل للمبلغ الأكبر. مَن يدفع أكثر، ينال الأفضلية: في الطعام، في التواصل مع الخارج، في الحماية، بل وحتى في التنقل داخل الجناح.
في هذا النظام غير المعلن، تسقط القوانين أمام سلطة المال، وتُلغى الفوارق بين نزيل ومُشغّل، وبين حارس ومستفيد. الجميع داخل اللعبة، والسجين الفقير وحده خارجها، يدفع الثمن من كرامته، وصحته، وربما حياته.
وهذا ما أكّده المحامي محمد صبلوح أيضاً، الذي كشف قصص سجناء متّهمين بالإرهاب أو القتل، ومن جنسيات غير لبنانية، يعيشون في ظروف أقرب إلى فنادق خمس نجوم: “غرف خاصة، مكيّفات، ثلاجات، إنترنت، وأحيانًا حرية تنقّل داخل السجن أشبه بامتياز خاص، وليس إجراء احترازي”.
واحدة من أخطر هذه الحوادث، بحسب صبلوح، تعود إلى فترة تولّي الوزير رضوان مرتضى، حيث هرب أحد السجناء مستغلاً اندلاع أعمال شغب حينها، ليتبين لاحقًا أن “الهروب” لم يكن إلاّ مسرحية مُنسّقة مع جهات داخل السجن، وأن السجين نفسه كان من النزلاء المحظيين الذين يتمتعون بمعاملة استثنائية.
وراء هذا التمييز الممنهج، تطرح تساؤلات مشروعة: أين ذهبت تبرعات بقيمة 100 ألف دولار خُصّصت سابقًا لتجهيز منظومة طاقة شمسية للسجن؟ ولماذا يُترك باقي السجناء لمصيرهم؟
في حادثة أخرى داخل سجن رومية، انتشر وباء في أحد الأقسام، وطالب المحامون بإجراء فحوص طبية عاجلة. الرد كان قاطعًا: “لا إمكانية”. السجناء أنفسهم اضطروا لتجميع المال من بعضهم وتكفّلوا بأجور طبيب خاص.
في المقابل، السجين الميسور تُفتح له الأبواب. طلب بسيط يُقدّم للنيابة العامة، فيُبت فيه، ويُرسل له طبيب فورًا. العدالة الصحية داخل السجن، كما العدالة القضائية، تخضع لمنطق المحسوبيات والمال، لا لحقوق الإنسان.
تمييز داخل الزنزانة كما خارجها
عملياً، التمييز لا يبدأ داخل الزنزانة، بل من لحظة دخول السجين. يُسأل مباشرة إن كان لديه مال. فالسجين الغني يُرسل إلى جناح “أكثر نظافة” أو يُستقبل بوساطة مألوفة. أما الفقير، فلا حول له ولا قوة، يكون من نصيبه السجن العادي الذي نعرفه جميعاً وليس سجن “الـ٥ نجوم” المستحدث.
في كثير من الحالات، يتعرّض هؤلاء الفقراء للتعذيب، ليس فقط الجسدي، بل النفسي أيضًا: من الحرمان من المكالمات، إلى تأخير جلسات المحاكمة عمداً، إلى إذلالهم من قبل بعض الضباط أو حتى زملائهم السجناء الذين يُعرفون غالباً بـ”شاويش” المبنى.
“الزيارات خفّت كتير عن قبل، خصوصي بفترة كورونا، وبعدها الحرب، متل كإن هالمكان الكبير بكلّ للي فيه ما حدا شايفو أو يمكن ما بدن يشوفوا… كأن نحنا حشرات مش ناس. هون مش بس مننحرم من حرّيتنا، ومن كرامتنا كمان”، يقول السجين (ز.ح.).
في الزوايا المعتمة من سجن رومية، لا يختبئ الجُرم فقط، بل ينعكس الواقع الاجتماعي بكل طبقاته وظلمه. السجن، كما تراه د. كوهار بالكيدجيان، ليس مجرد مساحة لعقوبة قانونية، بل مرآة حادّة لخللٍ أعمق في بنية المجتمع نفسه.
خلف القضبان، يُعاد تمثيل المشهد الخارجي بحذافيره: هناك مَن يملك المال والنفوذ، حتى داخل الزنزانة، وهناك مَن يفتقر إلى كل شيء حتى الشعور الانتماء الإنساني. هذا التفاوت لا يخلق فقط بيئة غير صحية، بل يدفع بعض السجناء إلى حافة الانهيار النفسي، حيث الاكتئاب، والعزلة، وأحيانًا التفكير في الانتحار يصبح واقعًا ملموسًا لا مجرد احتمالات.
لكن الأخطر، بحسب تجربتها، ليس فقط في ما يعيشه السجين، بل في أن هذه البيئة تُغلق عليه دائرة يصعب كسرها: تمييز، محسوبيات، غياب للتأهيل، وانعدام لأي خطة إصلاحية فعلية. السجون في لبنان لا تعيد تأهيل أحد، بل، في كثير من الحالات، تُعيد إنتاج الجريمة.
في ظل هذا الواقع، تحذّر بالكيدجيان من التمادي في تجاهل البُعد النفسي لما يحدث خلف القضبان، وتدعو إلى شراكة فعلية بين إدارة السجون واختصاصيي الصحة النفسية، قبل أن يتحوّل الانهيار النفسي إلى نمط دائم، والانعزال إلى هوية لا فكاك منها.
الزيارات متوقفة والأفضلية لـ”صاحب المال”
الزيارة الأسبوعية التي تعتبر شريان الحياة الوحيد للسجين، تحوّلت بدورها إلى امتحان طبقي. فالعائلات التي لا تملك المال الكافي لا تستطيع تحمّل كلفة التنقل من المناطق البعيدة إلى السجن، إضافة إلى ما يُطلب منها “كإكرامية” غير رسمية لتسهيل الزيارة أو تمديد مدتها.
بخوف وتردّد، وبعد محاولات عدّة ليتكلّم معنا، أخبرنا أحد العناصر في رومية (و.ض.) أنّهم “كانوا يعرفون أي عائلة تمتلك المال وأيّ عائلة على باب لله”.
تصريح العنصر الأمني لم يكن مفاجئاً، فالقوى الأمنية التي تتابع أدق التفاصيل ولا يغب عنها شيء، لن تعجز على إدارة سجن رومية، ولكن أمام ضعف إمكانيات الدولة ومواردها واكتظاظ السجناء وعدم تقاضي الضباط والعناصر مستحقاتهم، تتضح الصورة أكثر، فالعسكري الذي يتقاضى راتب ٢٠٠ أو ٣٠٠$ شهريا كيف له زن يعيل عائلته؟ من المنطقي أن يبحث عن مدخول ثان. وسجن رومية المكان المثالي لهؤلاء باعتباره ملعبهم.
اقتصاد داخلي ونظام خاص لـ”رومية”
من المستحيل فهم سجن رومية دون فهم اقتصاده الداخلي. هناك شبكة غير رسمية من التجار الصغار من السجناء أنفسهم، يبيعون كل شيء: من السجائر إلى الدواء إلى الملابس. ومَن يملك المال أو الدخان أو الهاتف الخليوي، يشتري كل ما يحلو له.
في ظل غياب المحاكمات السريعة والتأخير المقصود من بعض القضاة، يبقى السجين الفقير رهينة البيروقراطية، فيما الأغنياء ينجحون في دفع كفالات ضخمة أو استخدام العلاقات السياسية للخروج.
يكشف محامٍ متابع لقضايا السجناء، علي حمود، أن بعض الملفات “تُسرّع” إذا ما كان فيها طرف نافذ، أو إذا كانت العائلة قد دفعت “ما يلزم”. أما الفقير، يُركن ملفه جانبًا.
“المحكمة بتشتغل بالدفع. والقاضي بيتذكرك إذا في ظهر قوي أو محامٍ غالي. الباقي بيستنى. وساعات بيستنى سنين”، يقول حمود.
في رسالة سرية خرجت من السجن مؤخرًا، كتب أحد المساجين: “نحن لا نطلب رفاهية، فقط أن نُعامل كبشر. أن نأكل، وأن نُعالج، وأن نُحاكم.”
السجين نفسه حُرم من الدواء لأشهر رغم إصابته بقرحة مزمنة. وعندما نُقل إلى المستشفى، رُدّ لأنه لم يكن هناك مَن يدفع نفقات نقله، بحسب روايته.
في لبنان، لا تقتصر أزمة السجون على الاكتظاظ وسوء البنية التحتية فقط، بل تمتد لتشمل خللًا عميقًا في الأداء القضائي، خاصة في مرحلة التحقيق. هذا ما يسلط عليه الضوء القاضي داني زعنّي، الذي يرى أن جذور الظلم أحيانًا تبدأ من قرارات قانونية يفترض أن تكون عادلة.
القاضي زعني يعتبر أن قاضي التحقيق هو “أخطر” قاضٍ في مسار العدالة الجنائية، لأنه يمتلك السلطة لإبقاء شخص موقوفًا أو الإفراج عنه، ما يجعل قراره مؤثرًا جدًا على حياة الناس. فبحسب القاضي “هناك مَن لم يُحقق معهم منذ أكثر من خمس سنوات، في قضايا بسيطة مثل سرقة دراجة نارية”، أيّ أنهم قضوا أكثر من محكوميتهم ومع هذا لم يستمع القاضي إلى شهادتهم بعد!
وفي حديثه عن فرنسا، يوضح زعني أن هناك وعيًا بمدى خطورة دور القاضي وخبرته، ولهذا لا يُعيَّن قضاة التحقيق قبل سن 45، لضمان وجود نضج مهني وشخصي.
من منظوره، تدريب القضاة في لبنان “يركز على المعرفة القانونية فقط، دون أي تأهيل إنساني أو أخلاقي، لذلك غالباً من نجد القاضي يضرب عرض القوانين بالحائط بلا خجل أو ندم. ورغم أن القانون يعطي القاضي صلاحية نقض الأحكام أو التصرف بموجب ضميره، إلا أن زعني يشير إلى أن كثيرًا من القضاة في لبنان “لا يمتلكون الجَلَد”، أي لا يتحملون عناء مراجعة أو مواجهة النظام القضائي.
محكمة استثنائية داخل رومية
أنشئت المحكمة الاستثنائية داخل سجن رومية بوعود كبيرة لتسريع البتّ في ملفات الموقوفين وتخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية، لكن الواقع سرعان ما خيّب الآمال.
فبحسب شهادات عدد من المحامين الذين واكبوا عملها منذ انطلاقها، منهم صبلوح والموسوي وشديد، لم تحقّق المحكمة الغاية التي أُنشئت من أجلها. على العكس، سرعان ما تحوّلت إلى مساحة بيروقراطية إضافية، تتكرّر فيها الأعذار نفسها: نقص في عدد القضاة، عطلة قضائية تمتد بلا نهاية، وتضخم في عدد القضايا يفوق قدرة الفريق العامل.
المحصلة أن مئات الموقوفين ما زالوا في انتظار جلساتهم، وبعضهم تخطى المهل القانونية المنصوص عليها في المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، دون أي مؤشرات على تحرك فعلي.
مَن المسؤول؟
لفهم أبعاد الفروقات الطبقية وانعكاسها على سيكولوجية السجناء، حاولنا التواصل مع قوى الأمن الداخلي ولكن بسبب حساسية الموضوع وظروف البلد العامة لم يتم الإجابة على طلبنا حتّى الساعة.
بالمقابل، أوضح المستشار السابق في وزارة الداخلية اللبنانية، عمر نشابي، أن “تحميل القوى الأمنية مسؤولية ما يحصل داخل السجون هو طرح غير دقيق”، مؤكدًا أنها “تقوم بما يفوق قدرتها ضمن الإمكانات المتاحة، وتسعى جاهدة لتأمين الحد الأدنى من بيئة سجنية إنسانية وإصلاحية”.
كما أشار إلى أن “الواقع اللبناني القائم على أزمات اقتصادية، ومحسوبيات سياسية، واهتراء في النظام القضائي، يجعل مهمة القوى الأمنية بالغة الصعوبة، حتى وإن حاولت النأي بنفسها عن الضغوطات السياسية والتمييز في التعامل مع السجناء”.
وفي سياق الحديث عن القصور الإداري داخل المؤسّسات القضائية، كشف نشابي أن “أجهزة الحاسوب الخاصة بالقضاة في قصر العدل غير محصّنة أمنيًا، ما يفتح الباب أمام إمكانية التلاعب بالمحاضر والأحكام في حال وُجدت النية لذلك”. وأضاف أن “القضاة لا تتوفر لديهم حتى مياه الشرب في مكاتبهم، نتيجة انقطاع هذه الخدمة عن عدد من مباني قصور العدل، ما يعكس تردّي البنية التحتية للمؤسّسات العدلية في البلاد”.
فعلياً، لا يمكن إلقاء اللوم على سجن رومية وحده. فالمشكلة تعود إلى نظام قضائي مختل، وحكومة مهملة، ودولة تتعامل مع السجناء كأرقام لا كبشر. المسؤولية جماعية، تبدأ من وزارة الداخلية، إلى القضاء، إلى البرلمان الذي لم يصوّت حتى اليوم على قانون يضمن حقوق السجناء الأساسيّة.
لكن الأخطر أن هذا الواقع لم يعد مخفيًا. بل بات مقبولاً، كأنه جزء من الحياة، أو “عادي” كما يقول السجان حين يُسأل عن التمييز بين نزيل وآخر.
إدارة السجن تردّ وتؤكد المؤكد
رئيس مصلحة السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر لم ينكر الواقع، لكنه في الوقت نفسه لم يؤكده. ففي براغماتية قضائية تُحسب له أجاب أبي نادر على كل أسئلتنا دون تردّد.
عند سؤاله عن واقع السجن، أخبرنا القاضي بالصعوبات التي تُعيق عمل الأجهزة القضائية والأمنية، ذاكراً الأسباب الرئيسية التي صعّبت الأمور وزادتها سوءاً، كالانهيار الاقتصادي والحرب اللبنانية-الإسرائيلية وغيرها من المآسي التي عانى منها لبنان. لكن اللافت كان جوابه عن حالات الحرّش بالقاصرين في مبنى الأحداث.
لمَن لا يعرف، مبنى الأحداث اسم على مسمّى، من الطبيعي والبديهي أن يضمّ مَن هم تحت الـ١٨ عاماً، إلّا أنّه وبسبب الاكتظاظ يضم فرز عدد من البالغين إلى هذا المبنى، وهنا الكارثة.
هؤلاء البالغون يتحرّشون بالقاصرين، وقد تم تسجيل بعض الحالات فعلياً. وعندما سألنا القاضي، لم يؤكد الأمر، مشيرًا إلى أنهم لا يلتقون كثيرًا، لكنه أقرّ بأن وقوع بعض التجاوزات يبقى “أمرًا واردًا”.
ومن منطلق حقّ الرد، تواصلنا مع قوى الأمن الداخلي، لكن للأسف لم نتلقَّ تجاوبًا بسهولة، وجاء الرد متأخرًا جدًا بحجّة “انتظار الحصول على معلومات كافية من إدارة سجن رومية”، علمًا أن الفترة امتدّت لأكثر من ١٥ يومًا.
رومية ليس سجنًا فقط. إنه مرآة تعكس فشل الدولة، وفقدان المساواة، وغياب مفهوم العدالة. فمَن يدفع يعيش، ومَن لا يملك يموت ببطء.
في دولة تعاني من الانهيار الاقتصادي، سُجن الفقير مرتين: مرة باسم القانون، ومرة باسم الفقر. ولربما، كما قال أحد السجناء:”أنا يمكن مجرم، بس الدولة أكبر مجرم… لأنها خلتني أحس إنو حياتي ما إلها قيمة”.
هذا التقرير نتاج تعاون فريق صحافي وتقني تقاسم المهام بدقّة لإنتاج تحقيق استقصائي مصوّر ومتكامل، نشر على منصّة نقد, شاهدوه الآن.
أنجز التحقيق المكتوب من قبل الصحافية إيسامار لطيف بتعاون فريق منصة نقد الذي تولى انتاج العمل المصور بالكامل، كما النشر الحصري للتحقيق المكتوب والفيلم الاستقصائي المصوّر.
فريـــق عمـــل التحقيـــــــق
إيسامار لطيف
إدمون ساسين
تالين نهرا
علي عواضة
أنطوني بركات
ميتري ضاهر
جورج أبو عتمة
أيمن عيتاني
علي مرعي